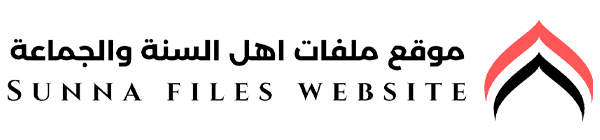الحمد لله وصلى الله على رسول الله وسلم، يدّعي بعض الملاحدة والمستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما قاموا بإحراق ما دوّن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستدلين على ذلك بالأحاديث الآتية:
– عن أبي هريرة رضي الله عنه قال “كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا، فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع، فقال: اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله، امحضوا كتاب الله أو خلصوه، قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار”.
– وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال “بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا قد كتبوا أحاديثه، فصعد المنبر وقال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ إنما أنا بشر، فمن كان عنده شيء منها فليأت بها. يقول أبو هريرة: فجمعناها فأخرجت”.
– عن عائشة رضي الله عنها قالت “جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا؛ فغمني، فقلت: أتتقلب بشكوى أم لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها، فدعا بنار فأحرقها، فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت فيه، ولم يكن كما حدثني
فأكون قد نقلت ذلك”.
– وعن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: “أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلي أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها، ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب”.
ويرمي أولئك الطاعنون من وراء ذلك إلى إنكار تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى حرق ما حفظ منها، انسلاخا من القول بحجيتها والعمل بها… وجوه إبطال تلك الشبهة:
1) لا وجه للاستدلال بحديثي أبي هريرة، إذ إن استنكار النبي صلى الله عليه وسلم كتابة حديثه كان في بادئ الأمر خشية أن تختلط السنة بالقرآن فيختلط الأمر على الناس، ولئلا يضاهى القرآن بشيء حتى ولو كانت السنة، هذا فضلا عن ضعف الحديث الثاني والنزاع حول صحة الأول.
2) ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أحرق أحاديث كانت عنده لا يصح سنده لأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى فرض صحته فلماذا لم يحذر من رواة الأحاديث وكاتبيها ويشهر المنع من ذلك وهو الخليفة آنذاك؟، فدل على أن ذلك غير صحيح.
3) ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إحراقه كتباً دوّنت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح لانقطاعه، إذ لم يثبت سماع القاسم بن محمد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
التفصيل:
أولا: حديثا أبي هريرة كانا في بادئ الأمر لعلة ألا تختلط السنة بالقرآن:
– إن الحديث الأول الذي يستدل به هؤلاء المدعون رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: “كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع، فقال: اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله أو خلصوه، قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار، قلنا: أي رسول الله أنتحدث عنك؟ قال: نعم تحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقلنا: يا رسول الله أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال: نعم، تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه”.
هذا وكثير من العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف إذ إنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما قال ابن حجر، فلا ينهض دليلا على أن النهي عن كتابة الحديث كان مطلقا ودائما، إذ إن ذلك على افتراض صحة الحديث، كان في بداية الأمر وكان الوحي ينزل قرآنا وسنة وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يرسخ العلم والإيمان في قلوب بعض الناس وقد يختلط عليهم الأمر فلا يفرقون بين ما هو من القرآن وما هو من السنة في تلك الصحف المتناثرة من الجلود والرقاع وسعف النخيل والعظام والحجارة، بل لم يكن القرآن نفسه قد جمع بعد في مصحف واحد، وهنا نعلم خطورة الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتابة إن صح ذلك، حتى لا يحدث التحريف الناشئ عن اختلاط القرآن بالسنة كما حدث في الأمم السابقة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “امحضوا كتاب الله أو خلصوه”، ثم أمر بحفظ حديثه والتحديث به وحذر من الكذب عليه، ولو كان المقصود محو السنن لما أمر بالتحديث عنه، وملعوم أن التحديث لا يكون إلا لما هو محفوظ، ولا يحفظ الحديث إلا بمدارسته ومراجعته.
والذي يدل على أن النهي عن كتابة الحديث النبوي كان مؤقتا في بداية الأمر وليس مطلقا ودائما فضلا عن العلل المذكورة في الحديث السابق، إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الكتابة مثال عبد الله بن عمرو وغيره، وأمره صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه سوء الحفظ أن يستعين بالخط، بل إن الأمر بالكتابة بعد ذلك صار عاما لقوله صلى الله عليه وسلم “قيدوا العلم بالكتاب” رواه الحاكم عن سيدنا عمر وهو في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي. والأحاديث في بيان الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم كثيرة حتى أفرد لها البخاري في كتاب العلم بابا خاصا بها سماه: باب كتابة العلم، وخصص له الخطيب كتابا سماه: تقييد العلم، وأفرد كثير من العلماء أبوابا لذلك مما يدل على أن استحباب كتابة العلم أمر مستفيض مشهور وأن النهي كان في بداية الأمر للعلل التي صاحبت ذلك النهي. قال الخطيب البغدادي “فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه، ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذ، لأنه لا يعرف حقها من باطلها، وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى عنها، وصار مهيمنا عليها، ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي القرآني وغير القرآني، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين فلم يؤمن أن يلحقوا من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن”.
– أما الحديث الثاني: رواه أيضا الخطيب البغدادي في تقييد العلم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: “بلغ رسول الله أن ناسا قد كتبوا حديثه، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟! إنما أنا بشر, من كان عنده منها شيء فليأت به؛ فجمعناها فأخرجت، فقلنا: يا رسول الله، نتحدث عنك؟ قال: تحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار”. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا سبق أن قلنا انه ضعيف ضعفه كبار علماء الحديث. فمما سبق يتضح أن هذا الحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعليه فلا مجال للاحتجاج به لأنه لا تصح نسبته إلى أبي هريرة رضي الله عنه فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلاف ذلك، إذ تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن كتابة الحديث النبوي بدأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بطريقة فردية”. فقد روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم “يا رسول الله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم، قلت: في الرضا والسخط؟ قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا” رواه الخطيب.
وهذا دليل على كتابة الصحابة للحديث بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره أحيانا، فقد أمر أصحابه أن يكتبوا لأبي شاه خطبته صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أبو شاه ذلك، هو في الترمذي وأبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة “اكتبوا لأبي شاه” قال الترمذي حديث حسن صحيح.
كما ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها بالصادقة (تقييد العلم للخطيب البغدادي). وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتاب فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم (فتح الباري شرح البخاري). وهناك الكثير من الأدلة نكتفي منها بما أوردناه، ليعلم الجاهل ويتنبه الغافل إلى أن كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أهم وسائل الحفاظ عليها. وإن ثبوت كتابة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة بعلمه وإذنه يقطع الطريق على الخائضين في السنة والحاقدين عليها على حد سواء.
وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من إحراق الأحاديث لا يصح لأن في إسناده راوياً مجهولاً، ذكره الذهبي وعلق عليه في تذكرة الحفاظ “هذا لا يصح والله أعلم”. على أن الذهبي ليس وحده الذي حكم بعدم صحة الخبر، وإنما رده أيضا ابن كثير حيث قال: “هذا غريب من هذا الوجه جدا، وعلي بن صالح – أحد رجال الإسناد – لا يعرف”. وهكذا يتضح أن الخبر غير صحيح، وفي إسناده راو مجهول، مما جعل الخبر في دائرة الرد، لا في دائرة القبول.
وهذا الخبر على فرض صحته ليس فيه دليل على ما أرادوه منه، فأبو بكر رضي الله عنه تردد في صدق الذي أملى عليه مجموعة الأحاديث، فسارع احتياطا إلى إعدامها بالحرق، حتى لا ينشر بين الناس أحاديث لم يتثبت كل التثبت من صدق صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحرقها لتردده في صدق راو واحد، هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث.
وما روي عن عمر رضي الله عنه من إحراق كتب فيها أحاديث لا يصح لانقطاعه لعدم سماع القاسم بن محمد من عمر فقد أخرجه الخطيب بإسناده عن القاسم بن محمد “أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب”؟!
ويريد عمر بن الخطاب في هذا الخبر أن يكون الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريم، فأراد أن ينبههم إلى عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخر، فإنه لا تجوز روايته بالمعنى، وإنما لا بد أن يحفظ لفظه، ويقرأ كما أنزله الله؛ ولذا يقول: “مثناة كمثناة أهل الكتاب”؟! وفي رواية أخرى: “إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله عز وجل” (رواه عبدالرزاق في المصنف).
وعمر يريد ألا يصرف الناس صارف عن القرآن الكريم، فهو المتعبد بلفظه، وهو الكتاب المهيمن. وهذا الخبر لا يفيد أن عمر أحرق الكتب خوف المدسوس فيها كما يدعي هؤلاء، وإنما أراد عمر أن يوفر الاهتمام كله للقرآن الكريم، وإلا فعمر ممن كتب كغيره من الناس، وكان يستجيز كتابة السنة. ومن جهة أخرى فإن الخبر الذي ذكره هؤلاء خبر لا يحتج به، جاءوا به ولم يبينوا لنا ما فيه من علة، فكان الواجب أن يقولوا: إنه من رواية القاسم عن عمر، والقاسم بن محمد بينه وبين عمر سنوات، فلقد ولد القاسم بعد وفاة عمر بثلاث عشرة سنة، وعليه فالإسناد منقطع، والانقطاع فيه ظاهر، وهو مما يضعفه، ويبعده عن دائرة الاحتجاج.
وهكذا يتضح لنا أن ما ادعاه هؤلاء من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أحرقا ما وصل إلى أيديهما من أحاديث رسول الله خشية التقولات والاختلافات تجن على الحقيقة، فما أحرق أبو بكر وإنما خبر إحراق الكتب غير صحيح، وما أحرق عمر، وإنما خبر إحراقه الكتب لا يصلح للاحتجاج به. ولقد بين الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت 360) وجه امتناع الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث، وتحديد معنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، عنها فقال “إنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول لقرب العهد، وتقارب الإسناد، ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، ويرغب عن حفظه والعمل به. فأما والوقت متباعد، والإسناد غير متقارب، والطرق مختلفة، والنقلة متشابهون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلم بالكتاب أشفى وأولى، والدليل على وجوبه أقوى، وحديث أبي سعيد “حرصنا أن يأذن لنا
النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأبى”، فأحسب أنه كان محفوظا في أول الهجرة، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن”.
قال الخطيب “إنما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف، بعد الكراهة لذلك، لأن الروايات انتشرت والأسانيد طالت، وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت، والعبارات والألفاظ اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك” (تقييد العلم للخطيب).
وبهذا يتضح أن النهي عن كتابة الحديث إنما كان في بداية الإسلام لعلل فصلناها، فلما زالت تلك العلل أبيحت الكتابة؛ إذ لم تكن محرمة في ذاتها سواء صاحب هذا النهي تحريق أم لم يصاحب.
الخلاصة:
– الحديثان اللذان استند إليهما الطاعنون في دعوى إحراق النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب من الأحاديث مدارهما على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواتهما وقد ضعفه كبار علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وليس هذا فحسب، بل إن الحديثين لم يصرحا بإحراق النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث أو أمره بذلك، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب منها مع القرآن.
– إن الخبر الذي روي عن أبي بكر أنه أحرق أحاديث كانت عنده لا يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف، وذلك لأن في إسناده راويا مجهولا.
– إن الخبر الذي استدل به هؤلاء على حرق عمر للأحاديث ضعيف لانقطاع السند فيه، فقد ولد القاسم بن محمد بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث عشرة سنة، وهذا ما يضعف الخبر ويخرجه من دائرة الاحتجاج. وعلى فرض صحته، فإنه كان يريد أن يوفر الاهتمام كله للقرآن الكريم، أو أنه خشي من اختلاطه بالسنة.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website