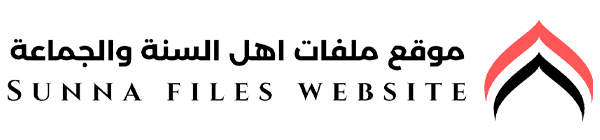“إن أحكام القيمة لديكم ونظرياتكم حول الخير والشر ليست سوى وسائل لممارسة السلطة”.
تُلخص مقولة نيتشه علاقة الأخلاق بالسلطة لبعضهم، وكيف أن “الأفكار والمواقف” تكون صائبة أو خاطئة أحيانا بحسب قوة معتنقيها أو ضعفهم، وكيف أن وضعها هو طريقة لممارسة سلطة بعضهم!
أولاً: علاقة الأخلاق بالسلطة:
لقد ظلت العنصرية ضد السود أمراً أخلاقياً تماماً لقرون، ولم ينكرها أغلب أعظم رجال عصرها، وحتى في إعلان الاستقلال الأمريكي، الذي حضَّ على قيم الحرية والعدالة والمساواة الإنسانية، فقد كانت هذه الحقوق محصورة بالعرق الأبيض فقط، دون أن يؤرّق ذلك ضمير أحد من منظري وفلاسفة الاستقلال.
واستمرت العنصرية أمراً أخلاقياً إلى أن حصل انقلاب فكري داخل مجتمع البيض أنفسهم، جعلهم يتبنون أخلاقيات المساواة بين البشر، فتحولت العنصرية إلى أمر مرفوض ومستقبح.
الأمر نفسه ينطبق على التحولات في الموقف الأخلاقي نحو اليهود، وظهور ما يسمى بمعاداة السامية كمعيار أخلاقي لا يمكن المساس به، ثم تحولات الثورة الجنسية، وتغير الحكم الأخلاقي على حرية الجسد والعلاقات خارج الزواج، حيث أصبحت الإباحية الجنسية فجأة أمراً أخلاقياً بمجرد اختراع موانع الحمل!
وكل هذه التحولات الأخلاقية كانت نتيجة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية وظرفية ما، أفرزت مواقف أخلاقية جديدة، تبنتها سلطة ما.
إن هذا ينطبق تماماً على قضية المثلية الجنسية، الذي تغير الموقف الأخلاقي منها ضمن سياقات سياسية وفكرية واجتماعية تفسّر هذا التغير، فإن كان نتيشه قد تحدث عن “أخلاق السادة” فإنّ أبرز ما ساهم في تغيير الموقف الأخلاقي من المثلية الجنسية هو “أخلاق هوليوود”، وجماعات الضغط المتنفذة التي مررت أجندتها إليها، ثم قامت التيارات السياسية بتبني هذا الموقف لتحقيق مكاسب سياسية بحتة!
إذًا الحكم الأخلاقي على المثلية هنا يستند إلى مرجعية ذاتية غير موضوعية، واستحسان عقلي بحت لدى فئة من الناس، وهو ليس مرتبطاً بمعايير علمية، بقدر ما هو نتاج صيرورة تاريخية وسياسية وثقافية، محصورة في زمان ومكان محددين، وبالتالي لا يمكن جعلها في كل الأزمنة والأمكنة الأخرى.
ثانياً: لكن ألم يثبت العلم أن المثلية ليست مرضاً؟!
قد يقول البعض “العلم هو المعيار، والعلم أثبت أن المثلية ليست مرضاً”.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
إن كون فعل ما “مرضاً” شيء، وكونه فعلاً “أخلاقياً” شيء آخر، فالقتل قد لا يكون ناجماً عن مرض، والسرقة قد لا تكون خللاً في المخ، والاغتصاب قد لا يكون قَدَراً جينياً، ولكنها أفعال مرفوضة أخلاقياً.
ثالثاً: صراع فكري أم صراع قوى؟
من الواضح وجود انقسام أخلاقي حول المثلية الجنسية، بين من يعتبرها مقبولة أخلاقيًا، كأطياف واسعة من المجتمعات الغربية، ومن يعتبرها غير مقبولة أخلاقيًا كأطياف واسعة من المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة حول العالم بشرقه وغربه. فلصّين الشيوعية الملحدة موقف صارم من المثلية، وإيطاليا الأوروبية المسيحية رفضت بالأمس تمرير قانون يدعم المثلية الجنسية.
إن الصراع هنا ليس صراعًا فكريًا بقدر ما هو صراع قوى، يريد فيه الأقوى أن يحتكر معايير الخطأ والصواب، ويجبر ث العالم أجمع عليها، في قضايا غير محسومة، لأنها ببساطة لا يمكن أن تُحسم، بل هي متروكة للاستحسان والاستقباح العقلي، حتى الآن على الأقل، ودينيًا هي مرفوضة البتّة.
ولذا فإن من حق أي مجتمع التمسك بمعاييره الأخلاقية السامية في رفض ما يريد اعتماداً على مرجعيته الأخلاقية، وأيّ محاولة لسلب هذه المجتمعات حقها وحريتها في وضع معاييرها الأخلاقية الخاصة هي عملية إرهاب فكري وسلخ ثقافي بالقوة.
إن أهم أدوات هذا الإرهاب الفكري المُمارَسة حالياً هي “الصوابية السياسية”، وسلوكيات “قُل ولا تقل”، ثم “ثقافة الإلغاء” التي بدأت تتوحش.
رابعاً: هل هذا يعني أننا في مجتمعاتنا العربية ليس لدينا خطاب كراهية ضد المثليين؟
بالطبع لدينا خطاب كراهية ضد المثليين، يتفجر فيه العنف والسيادة، ونفرغ فيه غرائزنا العدوانية غير المضبوطة في الغالب، ونلحظ هذا الخطاب مثلاً في التعليقات الوحشية على المنشورات التي تتعلق بهذا الموضوع، أو في حوادث الإيذاء والاعتداء، التي يغلّفها مقترفوها بثوب الدفاع عن الفضيلة.
وهذا الخطاب علينا محاربته لتقويمه، وعلينا حماية كل الناس بسلطة القانون وبدون تفرقة على أي أساس كان في مبدأ كهذا، فنحن علينا أن ندعو لمنع شاربي الخمر أو الزناة أو المثليين، وليس الهدف الانتقاص من حقوقهم ولا التمييز ضدهم، إنما استقامة الأفعال لديهم، لأن أي إيذاء أو تمييز سَيُفهَم غالبًا أنه غير أخلاقي، فهم أشخاص عاقلون وعلينا أن نعاملهم بطريقة تفضي لاستقامتهم.
أما الموقف القرآني الصارم تجاه المثلية فلم يكن موجهًا تجاه “أفراد”، بل كان موجهًا تجاه “قوم”، أي مجتمع كامل يريد فرض “مثليته” على الجميع، ويمارس في سبيل ذلك أساليب الضغط والإيذاء، كما في قصة النبي لوط عليه السلام، لذا فهذه الآيات ليست مبرراً لإطلاق العنان لوحشيتنا في التعامل مع “أفراد”، لأنهم يقومون بما هو خطأ، وإلا لَرأينا الناس تضرب بعضها بعضها في الطرقات عند كل خطيئة أو ذنب، بل إن الحكمة في التعامل أمر قلّ من يجيده مع كثرة وعظم فائدته.
خامساً: ماذا نستنكر في المثلية إذاً؟
ما علينا استنكاره في نقاش مسألة المثلية هو تحويل ما يفعله المرء في غرفة نومه إلى “هوية” يجاهر بها، في خضم الحرام مع ما يناقض العقل والدين.
وما علينا الوقوف ضده هو السماح لفئة قليلة في المجتمع، عاجزة عن التكيف مع بنية هذا المجتمع، وهي هنا بنيته الأسرية، إلى أن تعبث بهذه البنية وتنسفها من أجل أن تشعر بالانتماء!
وقد بتنا نرى في بعض المجتمعات الغربية إعادة تعريف لمفاهيم الذكورة والأنوثة، وخانات ثالثة ورابعة عند تحديد الجنس في استمارات الدولة، وبتنا نرى إعادة تعريف لمفهوم الأسرة إلى أسرة من رجلين وأسرة من امرأتين وربما أنواع أخرى غير مألوفة، وهذا ما هو مرفوض.
إن الجنسين يجب أن يبقيا ذكراً وأنثى فقط، وإن الزواج يجب أن يبقى بين رجل وامرأة فقط، ولا يجب أن نغير هذه المفاهيم من أجل أن نحتوي أفراداً قلّة لا تلائمهم بنية مجتمعاتنا هذه.
ومن أخطر ما علينا الوقوف ضده هو السماح لما سُمي “الأسر” المثلية بتبني الأطفال!
بل وكيف يحقّ لهم جعل الأطفال في بيئة غير سوية!
إن عمر تشريع الزواج المثلي لا يزال قصيراً جداً، ولا توجد بالتالي أي دراسات نفسية واجتماعية طويلة المدى، تحدد تأثير مثل هذه البيئة على نمو الأطفال وتفاعلهم مع المجتمع، فكيف يمكن المغامرة بحق الطفل في أن ينشأ نشأة سوية؟
وكيف نجرؤ أخلاقياً على استخدام أطفال لا يستطيعون أن يقرروا لأنفسهم لإثبات وجهات نظرنا الأخلاقية والترويج لها؟!
حين تدخَّلت الصين مثلاً في بنية الأسرة بشكل سافر وحددتها بطفل واحد فقط، استناداً إلى “استحسانها العقلي” لهذا التغيير، لم تتوقع أن يحصل فيها بعد ثلاثة أجيال هذه التبعات الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنفسية وغيرها!
هذا العبث لا تظهر آثاره إلا بعد أجيال وبعد دراسات مستفيضة، ولكن هذا الاستعجال في الرضوخ لجماعات الضغط المثلية ليس إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضمن خطط خمسية قصيرة.
سادساً: المثلية والعلم؟
إن وهم حرية العلم وحياديته هو وهم كبير، سبق أن كُتِب عنه، فالمؤسسات العلمية واقعة تحت تأثير القوى السياسية وسلطة رؤوس الأموال التي تمول أبحاثها، وهؤلاء بالتالي يتحكمون ببوصلة البحث العلمي، ويوجهون هذه البوصلة لطرح أسئلة محددة مسبقًا تخدم أجنداتهم السياسية والاقتصادية، ولذا لا نرى بحثًا جادًا يطرح أسئلة تُشكك في مدى “طبيعية” المثلية الجنسية، ومدى تأثير هذه التغيرات البنيوية على المجتمع.
إلا أنّنا نظن مع ذلك بأن المؤسسات العلمية في الدول الحرة بُنيت على أسس متينة، يصعب معها أن تسمح هذه المؤسسات لنفسها بأن تخدع نفسها، ولذا رأينا في 2019 صدور البحث العلمي الذي ينفي خرافة الجين المثلي، ويُثبت أن تأثير ما دُعِي بالجينات المثلية ضئيل جدًا مقابل تأثير البيئة والنشأة في تشكل الميول المثلية، وهنا تكمن خطورة الدعوة لتقبل المثلية العلنية، والترويج لها بلا هوادة، لأن هذا يغير في البيئة وظروف النشأة، ويعرّض الأطفال للتأثر بما كان من الممكن تجنبه تماماً.
وما زال أمام البشرية بعض الوقت حتى تستفيق من عبثها هذا، وتحرر نفسها من سطوة “أخلاق السادة” ودوغمائيتهم، وإرهاب جماعات الضغط والصوابية السياسية، وحتى ذلك الوقت لا يحق لأي مجتمع أن يستعلي أخلاقيًا، وأن يفرض منظومته الأخلاقية الخاصة كتقبل المثلية على المجتمعات الأخرى.
إن رفض المثلية الجنسية ليس خطاب كراهية، بل هو فعل مقاومة في وجه جزّاري الثقافات ومحتكري الحقيقة.