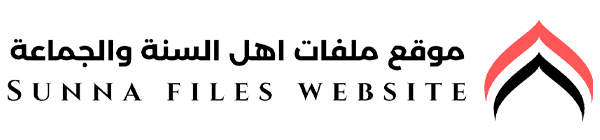حين استشهد عثمان بن عفان، رضي الله عنه، سنة 35 للهجرة/ 655 للميلاد، بايع المسلمون عليّاً بن أبي طالب، إلا أن رجلاً آخر كان يراوده حلم الإمارة، ألا وهو معاوية بن أبي سفيان، والي الشام، فاتخذ من حادثة مقتل عثمان جسراً لمعارضة علي، فنادى هو وجمع من الصحابة، وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، الذين كانوا على قرابة بسيدنا عثمان، رضي الله عنه، بالثأر من القتلة، إلا أن علياً كان له رأي آخر، ألا وهو أن يهادن الثوار بادئ الأمر، على أن يثأر منهم نهايته؛ أي عندما يضمن ولاءهم، وقال الحافظ ابن كثير في هذا: “ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة، رضي الله عنهم، وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان؛ فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا”، رفض الصحابة هذا المقترح، ووقع بين علي والصحابة معركة هزت العالم الإسلامي، سميت بمعركة الجمل 36 هجرية/ 657 ميلادية.
استشهد فيها كل من الزبير بن العوام، رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله. فما أن انتهى سيدنا علي من معركة الجمل حتى دخل في أخرى، وهذه المرة واجه فيها معاوية بن أبي سفيان، الذي رفض مقترح علي هو الآخر، وأبى بيعة علي، فعزله علي من ولاية الشام، فتأججت الوضعية أكثر فأكثر، إلى أن وقعت بين الاثنين معركة شهيرة “صفين 37هـ/658م” انتصر فيها علي.
فالذين اختاروا صف علي سموا أنفسهم شيعة علي؛ أي فرقته، وهؤلاء انشق منهم رهط كثير بعد حادثة التحكيم المشهورة، ولقبوا تاريخيًا بالخوارج.
فما هي الأحداث التي عرفها العالم الإسلامي وسببت ظهور المذهب الشيعي؟ وما نتائج هذه الأحداث على العالم الإسلامي وعلى الإسلام؟ وهل صحيح أن الشيعة هم أول من خان آل البيت؟ وما تفسير الغلو في حب آل البيت لدى الشيعة؟
لقد أصبح حب علي مرادفًا لحب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصبح اسمه مرتبطًا به، فقد كان صورة مصغرة عن الحبيب؛ فكان يحسن معاملة الناس، ويرأف بهم، وخاصة الموالي، حديثي الإسلام، فزاد عطف “علي” عليهم وإحسانه إليهم من تقديسهم له، وارتباطهم به، فعلي الذي نعرفه، والذي تربى في كنف أفضل الخلق لم يتغير؛ فهو المتواضع اللين؛ الكيس، كان يجلس مع بقال فارسي يدعى ميثم التمار، ويبيع عنه إذا ما غاب لقضاء حاجة؛ فمن هذا الذي لا يعجب بأمير المؤمنين؟!
وكيف لا يحبون علياً وفيه قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي”. وهو الذي اختاره الحبيب يوم خيبر ليحمل راية الإسلام، فقال فيه: “لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله عليه، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره”.
وإن أول العهد بالتشيع انطلق من بلاد عرب بحتة؛ فقد اختار علي الكوفة على المدينة؛ كونها مصدر الثورات والانقلابات، والتاريخ يحدثنا عن كون عبد الله بن سبأ أول من أسس مذهب التشيع لعلي، وبنى مذهبه على ألوهية الإمام علي، وهو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، فلما بلغ ذلك الإمام نهاه وزجره، وأراد قتله، فنهاه البعض عن ذلك فتركه يرحل لحال سبيله، وهناك من يربط تشيع أهل العراق بزمن آخر غير زمن سيدنا علي، إذ يرى المؤرخ “السير أرلوند” أن دوافع إقبال أهالي العراق على التشيع زواج الحسين بن علي من إحدى بنات يزدجر آخر أكاسرة الفرس، وعموماً فقد انتشر مذهب التشيع وتطور إلى تأليه علي، فيروى أن علياً أمر بحفر خندق وأضرم فيه النار، وألقى فيه بعض من ألّهوه فقالوا: “والله أنت أنت؛ فلا يعذب بالنار إلا رب النار”.
لقد وجد الناس، وخاصة الموالي (المسلمين غير العرب) في مذهب ابن سبأ استمرارية للديانات السابقة ومذاهب العراق وفارس، فقد كانت هذه البلاد منبعاً للديانات المختلفة والمذاهب الغريبة “الماناوية والمزدكية…”.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
لقد تطورت الأحداث ومعها تطور التشيع شيئًا فشيئًا، فعلي قد استشهد (قتله أحد الخوارج يدعى ابن ملجم)، فكانت الخلافة من بعده لابنه الحسن، وبسبب تعنت خصم علي “معاوية” وإصراره، ارتأى الحسن بن علي أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية حقنًا لدماء المسلمين. لكن تنازل الحسن لم يعن تنازل آل البيت عن حقهم؛ فظهر للعيان أخوه الحسين، رضي الله عنه، منافسًا جديدًا وثائرًا يهدد عرش الأمويين وينغص على معاوية حكمه، لكن الحسين ظل في فترة معاوية مهادنًا لا يسمع له صوت، وكان السبب ما روى ابن قتيبة أن الحسن قال لشيعته:
“ليكن كل رجل منكم حلسًا من أحلاس بيته ما دام معاوية حيًا، فإنها بيعة كنت والله لها كارهًا، فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم، ورأينا ورأيتم”. كما يذكر ابن كثير فإن الحسن لم ينو قتال أحد. لهذا تعمد الحسين الركون والاستكانة، فما أراد نقض بيعة الحسن لمعاوية، لكن رأيه لم يتغير أبدًا.
وها هو معاوية يرحل قاصدًا أبناء الصحابة (عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير) في الحجاز ليستطلع رأيهم في تولية ابنه “يزيد”، دون أن يلتقي بالحسن والحسين؛ فقد كان يعرف رأيهما مسبقًا (هذا يؤكد أن معاوية وإن حاول استمالة آل البيت فإنه كان أدرى الناس برأيهم فيه)، لم يوافق أبناء الصحابة على تولية يزيد، ما جعل معاوية يعدل عن الأمر ويؤجله. واستطاع معاوية فيما بعد أن يهنأ بملكه، خاصة بعد الصلح الذي حدث بينه وبين الحسن، رضي الله عنه، وذاك في سنة 41 هجرية/ 661 ميلادية؛ إذ وقع الطرفان معاهدة تضمنت عدة شروط على رأسها “تعهد فيها معاوية ألا يعين ابنه من بعده”، لكن المعاهدة فقدت قيمتها بعد وفاة الحسن سنة 50 هجرية/ 670 ميلادية عن عمر يناهز سبعاً وأربعين سنة.
ولما توفي معاوية (60 هجرية/ 680 ميلادية) تولى يزيد الخلافة، فلم يبايعه أحد من أبناء الصحابة، فأراد أن يأخذها بالقوة، فكتب إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة: “أما بعد، فخذ حسينًا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذًا شديدًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا.. والسلام”. ثم أفرد لكل واحد منهم كتبًا.
فلم يبايع الحسين يزيدًا، وخرج الحسين إلى مكة، وكانت هذه فرصة أهل العراق الكارهين لحكم الأمويين؛ فرأوا أن يكتبوا للحسين: “ويروى أنهم كتبوا لهم 50 كتابًا”.
وبقي الحسين، رضي الله عنه، في حيرة من أمره، إلى أن رأى أن يستجيب لهم؛ فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليمهد له الطريق ويعرف أهواء الناس. وتوافد الشيعة إلى بيت المختار الثقفي (أحد كبار السياسيين في التاريخ الإسلامي) الذي جعل بيته حصنًا يحتمي فيه مسلم ويلتقي فيه بشيعة الحسين.
لكن سرعان ما غادر مسلم بيت المختار ليلتحق ببيت “هانئ بن عروة” بعد أن قدم موفود يزيد إلى الكوفة وهو “عبيد الله بن زياد”، لهذا ارتأى “مسلم” أن يستقر في بيت هانئ لكونه أحد أشراف العراق، الأمر الذي لم يشفع له؛ فسرعان ما قتل هانئ على يد ابن زياد، ووصل خبر مقتل هانئ إلى مسلم بن عقيل؛ فجمع خلقاً كثيراً وصل عددهم إلى 30 ألف رجل، لكن 30 ألفاً تضاءلت إلى أن وصل عدد الناس حول “مسلم بن عقيل” إلى 30 رجلاً فقط. حتى إذا صلى بهم العشاء وجد نفسه وحيداً. فقبض عليه ابن زياد وقتله وأمر بإلقائه من علٍ، فاستشهد عقيل.
لقد نجح ابن زياد في استمالة أشراف الكوفة بإغداق الهدايا والعطايا، لما علم من حبهم للدنيا وتنافسهم عليها، وبهذا نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين آل البيت، فقال الفرزدق للحسين: “قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية”.
لم يكن الحسين على علم بمقتل رسوله “مسلم”، فراسل الشيعة من جديد الحسين، وقدموا له العهود والمواثيق الغلاظ، فما كان إلا أن استجاب لهم، رغم تحذيرات أبناء الصحابة له؛ فقد حاولوا ثنيه عن العزم وتذكيره بما حدث مع أخيه، ومن قبله لسيدنا علي الذي قتل على يد الخوارج من أهل العراق، رضي الله عنه وأرضاه، وما أن وصل الحسين إلى القادسية حتى علم بمقتل مسلم بن عقيل؛ فأراد العودة، رضي الله عنه، إلا أن إخوة مسلم بن عقيل رفضوا الفكرة، وقرروا المضي قدمًا، فأرسل إليهم ابن زياد جيشًا تجاوز عدده 20 ألفًا، ما بين فارس وراجل ليقاتلوا الحسين. انتهى القتال باستشهاد الحسين بعد أن قاتل ببسالة وشجاعة في معركة خالدة تسمى معركة “كربلاء” 10 محرم 61 هجرية/680 ميلادية.
استشهد الحسين إذًا، وتفرق دمه بين الأمويين والشيعة، فكل واحد منهم غرس سهمًا في جسده الطاهر، لقد صدقه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حين قال له: “أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم، وضبطوا بلادهم، ونفوا عدوهم؛ فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم، وعماله تجبي بلادهم، فإنما دعوك إلى الحرب، ولا آمن عليك أن يغروك، ويكذبوك، ويخالفوك، ويخذلوك، ويستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك!”.
لم يأخذ الحسين بما حصل سابقًا من التاريخ، فها هو يرى ابن زياد يقتل الشيعة وينكل بهم، ويصلب مسلمًا بن عقيل بعد أن رماه من علٍ. وهو الذي كان من أشد الناس حبًّا فيما مضى لعلي، ها هو اليوم يعلنها حربًا شعواء على الشيعة وآل البيت.
ومما يذكر الدكتور علي الوردي “أن رجلًا عرف بتحمسه للحسين بن علي، فكان يكثر من الحديث عنه، ويذكر مناقبه، ويتمنى لو أنه لحق به فينصره نصرًا مبينًا، فإذا به يرى في منامه، أن الحسين محاط بالفرسان من كل جهة، وهو ينظر إليه، حتى إذا ما رآه الحسين أعطاه درعه وسيفه وقال له دافع عني، فلما رأى الرجل عزم الناس على قتل الحسين هرب ولم يعقب، فلم يخذل الحسين فقط، بل سرق درعه وسيفه أيضاً”.
رغم كونها قصة غريبة بعض الشيء، فإنها تفضح زيف ادعاء البعض حب آل البيت والذود عنهم، حسب الدكتور علي الوردي.
بعد حادثة مقتل الحسين زاد اضطهاد الأمويين للشيعة، فنكلوا بهم وصلبوهم وعذبوهم. فكان أن زاد الناس تعلقًا بالتشيع وكرهًا للأمويين، بل وصل بهم الأمر إلى اتخاذ أحد الناس، وكان يشبه علياً بن أبي طالب، إلهًا! لقد عانى الشيعة من الاضطهاد، لقد أصبح حب علي مرادفًا للثورة، أصبح حب علي سيئة، والناس كما نعلم إذا ما كرهت النظام الحاكم بحثت عن أي أمر يكرهه النظام فتعلقت به، فكان أن تعلق الناس بعلي وآل بيته، وقدسوهم إلى حد الألوهية.
مع استمرار الصراع بين آل البيت والأمويين، خاصة مع تولي عبد الله بن الزبير الخلافة على الحجاز، ثم ظهور “المختار الثقفي” و”محمد بن الحنفية”، وكذا “سليمان بن الصرد” مؤسس حزب التوابين الذي سينافس المختار الثقفي فيما بعد، استمر ظهور طوائف مختلفة من الشيعة، واستمر الابتداع؛ فظهرت فرق كثيرة كاد لا حصر لها من الشيعة، على رأسها الإسماعيلية، والزيدية، والاثني عشرية، وهي أكبر مذاهب الشيعة حضوراً اليوم.
ولم تهدأ الأمور حتى بعد سقوط الخلافة الأموية (750م) ووصول الخلافة العباسية، التي استفادت من قوة آل البيت “الرضا من آل محمد”، واندفاع الموالي من أهل الأمصار البعيدة الذين رأوا في الأمويين حكامًا عنصريين (تفضيل العرب والقرشيين بالتحديد على باقي المسلمين)، وقَتَلة يجب الانتقام منهم؛ فكان الشعار الذي ما زال حياً ليومنا هذا “يا لثارات الحسين”. لقد أضحى الحسين المحرك الأساسي للفرق الشيعية، وملهمهم الأول وصانع معجزاتهم بنظرهم، فتراب الحسين يشفي المرضى، وزيارة قبره بألف حجة، وحبه يدخل صاحبه الجنة دون حساب، وكل من وقف ضد آل البيت مخلد في النار ملعون إلى يوم الدين، وعلى رأسهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، رضي الله عنهم أجمعين، ويروون في ذلك أحاديث كثيرة.
لقد تحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع مذهبي راح ضحيته الآلاف، إن لم نقل الملايين.
وذكرى معركة كربلاء تخلد كل سنة في العاشر من الشهر الهجري المحرم، وتقام الاحتفالات التي يغلب عليها البكاء والندب واللطم، وتحتفي كربلاء بزواره القادمين من كل حدب وصوب، فالمذهب الشيعي وجد لنفسه مكانًا في الشرق “باكستان والهند…”، والغرب “مصر وليبيا…”، ولو أن شيعة الشرق أكثر بكثير من شيعة الغرب.
إن الشيعي يتألم لمقتل الحسين كما يتألم السني ويتألم كل إنسان حر، فقضية الحسين لم تكن في يوم من الأيام قضية الشيعي أو قضية المسلم فقط، بل قضية كل إنسان، إنسان؛ فالحسين قبل أن يكون حفيدًا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأحد أهم الشخصيات التاريخية، فهو إنسان، إنسان بكل ما تعني الكلمة، إنسان رفض الخنوع والاستكانة، وأن يترك الملك لمن لا يستحقه، وأن يرى أموال المسلمين تؤكل بالباطل، الحسين يمثل في عصره وكل العصور أيقونة حية لأحرار العالم، منه نرتشف الحرية عذبة صافية لا دنس فيها، الحسين رمز التضحية، والحسين للكل لا للشيعة وحدهم.
لكنّ ما يقام من احتفالات يتجاوز مسألة الحب وحتى الحزن، ويدخل في خانة البدع الخاطئة، فهل يا ترى كان رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ليسر بمنظر الناس وهي تشق الجيوب واللحى تقطر دماً، والأدهى والأمر أن هذه الطقوس لا تقتصر على البالغين، بل نرى كوكبة أطفال تخترق الجموع في مشهد محزن ومؤسف.
ألا يفكر الشيعي في أنه لا الله ولا رسول الله ولا علي ولا الحسين يرضيه ما وصل إليه من طقوس ما أنزل الله بها من سلطان!
وفي النهاية يبقى الصراع بين السنة والشيعة صراعاً مفتعلًا في أحيان كثيرة، صراعًا لا طائل منه، صراعًا استغل قديمًا ويستغل حديثًا أيما استغلال من القوى السياسية، والناظر إلى حقيقته يراه مرضًا عضالًا نخر جسد هذه الأمة، “أمة التيه الجديدة”، وإعصارًا يأتي على من تبقى من معالم الحضارة الإسلامية العظيمة، والحائل الأول بين المسلمين وتشكيل اتحاد ينسيهم شتات الماضي، ويحيي فيهم الأمل في رؤية العالم الإسلامي متحدًا مرة أخرى كما كان ذات يوم على الصراط المستقيم متخذين الرسول الاكرم وصحابته قدوة.