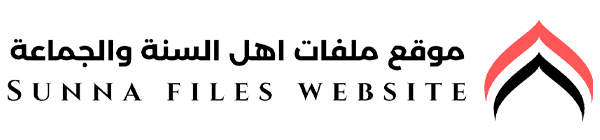لقد وصف صحراء الجزيرة العربية بعد مدينة معان في جنوب الأردن بأنها “التي يقال فيها: داخلها مفقود وخارجها مولود”. وقد صدق في هذا الوصف؛ لوعورة الطريق، وخطر قطاعه، وشدة الحر، ورياح السموم التي أتت على القوافل في بعض السنين، فلم يفلت منها إلا القليل.
لقد تمكن الركب الشامي ومعهم ابن بطوطة من دخول المدينة المنورة، وهو يصف المسجد النبوي قائلاً: “المسجد المعظم مستطيل تحفُّه من جهاته الأربع، بلاطات دائرة به، ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل، ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلّط بالحجر المنحوتة، والرّوضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها، في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم، وشكلها عجيب لا يتأتى تمثيله، وهي مؤزّرة بالرخام البديع النحت، الرائق النعت، قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان، وفي الصفحة القبلية منها مِسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم، وهناك يقفُ الناس للسلام مستقبلين الوجه الكريم، مستدبرين القبلة”.
لقد وقف ابن بطوطة كثيرًا مع المدينة المنورة، ووصف لنا المسجد النبوي وخدَمه، وراح ينقل بعض حكايا الناس، مشاهيرهم ومغاميرهم في تلك المدينة العطرة، وهي حكايا تصف لنا الجانب الإنساني والاجتماعي في تلك البقاع المشرفة، فضلاً عن ثقافة ذلك العصر.
على أن الركب بعدما قضى الزيارة للحرم النبوي الشريف، ومكث غير قليل في تلك المدينة العطرة التي أحسن ابن بطوطة وصف مشاهدها وعمرانها وبقاعها وشخوصها، انتقل إلى وصف الطريق من جديد بين مكة والمدينة، وهي طريق وعرة، شديدة الخطورة، حتى منّ الله عليهم بالوصول إلى مشارف مكة المكرمة.
يقول ابن بطوطة حين تراءت له نسائم مكة، وشم عبيرها وريحها، وتملّى من بعيد ببهائها: “ومن عجائب صنع الله تعالى أنّه طبع القلوبَ على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة، والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبّها متمكنا في القلوب فلا يحلّها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلّا أسفا لفراقها، متولّها لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناويا لتكرار الوفادة عليها، فأرضها المباركة نصب الأعين، ومحبتها حشو القلوب حكمة من الله بالغة، وتصديقا لدعوة خليله عليه السلام، والشوق يحضرها وهي نائية، ويمثلها وهي غائبة، ويهون على قاصدها ما يلقاه من المشاقّ ويعانيه من العناء، وكم من ضعيف يرى الموت عيّانا دونها، ويشاهد التّلف في طريقها، فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورا مستبشرا كأنه لم يذُق لها مرارة، ولا كابد محنة ولا نصَبا، إنه لأمر إلهي، وصنع ربّاني، ودلالة لا يشوبها لبس ولا تغشاها شبهة، ولا يطرقها تمويه، تقوي بصيرة المستبصر، وتُسدد فكرة المتفكر”.
أما مناسك الحج في ذلك الزمن؛ فإن الاستعداد كان يجري على قدم وساق منذ اليوم الأول من ذي الحجة من كل سنة؛ فـ”إذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تُضرب الطبول والدّبادب في أوقات الصلوات وبكرة وعشية إشعارًا بالموسم المبارك، ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات”.
وفي اليوم السابع من ذي الحجة “يخطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة بليغة يعلّم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة”. وفي اليوم التالي يوم التروية يذهبُ الناس إلى مشعر منى، وفيه “يبكّر الناس بالصعود إلى منى، وأمراءُ مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنى، وتقع المُباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع (للإضاءة)، ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام دائمًا”.
فإذا انتهى يوم عرفة، وحان وقت النفر إلى مُزدلفة لاستكمال مناسك الحج “أشار الإمام المالكي بيده ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعة ترتجُّ لها الأرض وترجف الجبال فياله موقفا كريما، ومشهدا عظيما، ترجو النفوس حسن عقباه، وتطمح الآمال إلى نفحات رُحماه”.
ولما كسيت شمّرت أذيالها صونًا عن أيدي الناس، والملك الناصر (محمد بن قلاوون السلطان المملوكي ت 741هـ) هو الذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة، ويبعثُ مرتبات القاضي والخطيب والأئمة والمؤذنين والفرّاشين والقَوَمة وما يحتاج له الحرم الشريف من الشّمع والزيت في كلّ سنة”.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
لقد وصف صحراء الجزيرة العربية بعد مدينة معان في جنوب الأردن بأنها “التي يقال فيها: داخلها مفقود وخارجها مولود”. وقد صدق في هذا الوصف؛ لوعورة الطريق، وخطر قطاعه، وشدة الحر، ورياح السموم التي أتت على القوافل في بعض السنين، فلم يفلت منها إلا القليل.
لقد تمكن الركب الشامي ومعهم ابن بطوطة من دخول المدينة المنورة، وهو يصف المسجد النبوي قائلاً: “المسجد المعظم مستطيل تحفُّه من جهاته الأربع، بلاطات دائرة به، ووسطه صحن مفروش بالحصى والرمل، ويدور بالمسجد الشريف شارع مبلّط بالحجر المنحوتة، والرّوضة المقدسة صلوات الله وسلامه على ساكنها، في الجهة القبلية مما يلي الشرق من المسجد الكريم، وشكلها عجيب لا يتأتى تمثيله، وهي مؤزّرة بالرخام البديع النحت، الرائق النعت، قد علاها تضميخ المسك والطيب مع طول الأزمان، وفي الصفحة القبلية منها مِسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم، وهناك يقفُ الناس للسلام مستقبلين الوجه الكريم، مستدبرين القبلة”.
لقد وقف ابن بطوطة كثيرًا مع المدينة المنورة، ووصف لنا المسجد النبوي وخدَمه، وراح ينقل بعض حكايا الناس، مشاهيرهم ومغاميرهم في تلك المدينة العطرة، وهي حكايا تصف لنا الجانب الإنساني والاجتماعي في تلك البقاع المشرفة، فضلاً عن ثقافة ذلك العصر.
على أن الركب بعدما قضى الزيارة للحرم النبوي الشريف، ومكث غير قليل في تلك المدينة العطرة التي أحسن ابن بطوطة وصف مشاهدها وعمرانها وبقاعها وشخوصها، انتقل إلى وصف الطريق من جديد بين مكة والمدينة، وهي طريق وعرة، شديدة الخطورة، حتى منّ الله عليهم بالوصول إلى مشارف مكة المكرمة.
يقول ابن بطوطة حين تراءت له نسائم مكة، وشم عبيرها وريحها، وتملّى من بعيد ببهائها: “ومن عجائب صنع الله تعالى أنّه طبع القلوبَ على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة، والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبّها متمكنا في القلوب فلا يحلّها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلّا أسفا لفراقها، متولّها لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناويا لتكرار الوفادة عليها، فأرضها المباركة نصب الأعين، ومحبتها حشو القلوب حكمة من الله بالغة، وتصديقا لدعوة خليله عليه السلام، والشوق يحضرها وهي نائية، ويمثلها وهي غائبة، ويهون على قاصدها ما يلقاه من المشاقّ ويعانيه من العناء، وكم من ضعيف يرى الموت عيّانا دونها، ويشاهد التّلف في طريقها، فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورا مستبشرا كأنه لم يذُق لها مرارة، ولا كابد محنة ولا نصَبا، إنه لأمر إلهي، وصنع ربّاني، ودلالة لا يشوبها لبس ولا تغشاها شبهة، ولا يطرقها تمويه، تقوي بصيرة المستبصر، وتُسدد فكرة المتفكر”.
أما مناسك الحج في ذلك الزمن؛ فإن الاستعداد كان يجري على قدم وساق منذ اليوم الأول من ذي الحجة من كل سنة؛ فـ”إذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تُضرب الطبول والدّبادب في أوقات الصلوات وبكرة وعشية إشعارًا بالموسم المبارك، ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات”.
وفي اليوم السابع من ذي الحجة “يخطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة بليغة يعلّم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة”. وفي اليوم التالي يوم التروية يذهبُ الناس إلى مشعر منى، وفيه “يبكّر الناس بالصعود إلى منى، وأمراءُ مصر والشام والعراق وأهل العلم يبيتون تلك الليلة بمنى، وتقع المُباهاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع (للإضاءة)، ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام دائمًا”.
فإذا انتهى يوم عرفة، وحان وقت النفر إلى مُزدلفة لاستكمال مناسك الحج “أشار الإمام المالكي بيده ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعة ترتجُّ لها الأرض وترجف الجبال فياله موقفا كريما، ومشهدا عظيما، ترجو النفوس حسن عقباه، وتطمح الآمال إلى نفحات رُحماه”.
ولما كسيت شمّرت أذيالها صونًا عن أيدي الناس، والملك الناصر (محمد بن قلاوون السلطان المملوكي ت 741هـ) هو الذي يتولى كسوة الكعبة الكريمة، ويبعثُ مرتبات القاضي والخطيب والأئمة والمؤذنين والفرّاشين والقَوَمة وما يحتاج له الحرم الشريف من الشّمع والزيت في كلّ سنة”.