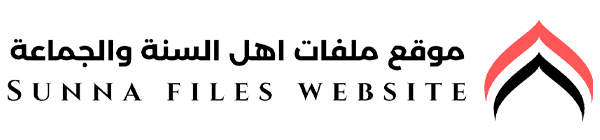تجري العادة عند الكتابة عن الاحتلال -أيّ احتلال- أن يُسطِّر الكاتب تاريخاً مؤلماً بشعاً عن المحتل، لكن في حالة الاحتلال الفرنسي، تحديداً، فلا أدري أتنزف الحروف دماً أم حبراً؟!
وأنا هاهُنا أضع بين أيديكم غيضاً من فيضٍ عما نزفته الآلاف في شتى البلاد والأزمان تحت وطأة الطاحونة الفرنسية الجاحدة، ولست على ذلك مؤرِّخاً، فللتاريخ أصحابه ومصادره، لكنه طرحٌ لبعض المُسلَّمات والحقائق المؤلمة، ووضعٌ للنقاط على الحروف، وتذكيرٌ لنا -قبل غيرنا- بخِسة أعداء الدين ودناءة أفعالهم، وبراءة الإسلام السمح مما ينسبون.
إن ما عُرفَ عن “الفرْنَسَة” منذ وُلدت فصارت سرطاناً دمويّاً استئصاليّاً، يقتات على أرواح الشعوب والأمم، أنها لا تُبقي ولا تذر أرضاً أو روحاً، وذلك مُذ بدء شرارة الحملات الصليبية عام 1095م على يد البابا “أوربان الثاني” الفرنسي الأصل، مروراً بالحملة السابعة بقيادة “لويس التاسع” ملك فرنسا، والتي راح ضحيتها أكثر من 3 ملايين نفسٍ أُزهقت بدعوة من الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية، من أجل الاستيلاء على القدس ومنع توغل الإمبراطورية الإسلامية، حتى يومنا هذا وما يفعلونه من الاستهزاء بالمسلمين وشعائرهم وممارسة أبشع الجرائم في حقهم، تحت قناع “الإنسانوية” والحريات البغيض الذي يتستَّرون خلفه.
منذ أواخر القرن السابع عشر، وعلى أرضٍ جديدةٍ غرب المحيط الهادي، اندلعت واحدة من أبشع وأهم الصراعات العدائية في أمريكا الشمالية بين القطبين الفرنسي والبريطاني، والتي غيَّرت دماء القارة الهندية، وسلبت أهلها الأرض والعرض. ثلاثة صراعات رئيسية كانت محور الارتكاز:
- حرب الملك “ويليام” (1689-1697)
- حرب الملكة “آن” (1702-1713)
- حرب الملك “چورچ” (1744-1748)
وقد بدأت جميعها في أوروبا، وشقَّت طريقها إلى المستعمرات. كانت الحرب الفرنسية والهندية آخر وأهم سلسلة من الصراعات الاستعمارية بين البريطانيين والمستعمرين الأمريكيين من جهةٍ، والفرنسيين وشبكتهم الواسعة من حلفاء الأمريكيين الأصليين من جهةٍ أخرى، وبدأ القتال في ربيع عام 1754م، رغم أن بريطانيا وفرنسا لم تعلنا الحرب رسميًّا حتَّى مايو 1756 م، وبها اندلعت حرب “السنوات السبع” في أوروبا. سبع سنين، هي حربٌ ضروسٌ بين غريمين شقيقين، لكنها جاءت على الأخضر واليابس، انتُهِكت بحجتها دماء الهنود الحمر وسُلبت أراضيهم وهُجِّروا منها، وشُيِّد فوق رفات أبنائهم تمثال الحرية المزعوم والديمقراطية الظالمة.
ومن القارة الجديدة إلى القارة السمراء، بدءاً بالحملة الفرنسية على مصر، والتي استمرت ثلاث سنوات (1798-1801)، مروراً بالعدوان الثلاثي، شاع خلالها الفرنسيون قتلاً وتشريداً ونهباً وسرقةً وانتهاكاً للمسلمين ومقدساتهم الدينية، حتَّى اتَّخذوا من صحن الجامع الأزهر “إصطَبْلاً” للخيول، وأحرقوا المصاحف وداسوها بأقدامهم القذرة. ومن مصر إلى الجزائر حيث أطول وأبشع احتلال أجنبي لبلدٍ عربيٍّ استمر قرابة 130 عاماً، قدَّمت فيها الجزائر ما يزيد عن المليون شهيدٍ أو يزيد، منهم 45 ألفاً سقطوا دفعةً واحدةً بقذائف المدافع بعد خروج الجزائريين مطالبين بالاستقلال إثر الحرب العالمية الثانية، ناهيك عن الحملات البشعة ضد أهل القرى والنجوع من قتل الأطفال والشيوخ وحرق العلماء وإذابة أجسادهم أحياء في قوالب الإسفلت، ختاماً باليرابيع النووية الـ3 في الصحراء الجزائرية، والتي بدأت بتجربة “اليربوع الأزرق” في 13 فبراير/شباط 1960 بمنطقة “رقان” ومنطقة “حمودية” بالجزائر، ودفع ضريبتها آلاف الجزائريين المعتقلين وأسرهم.
وقد طال البطش والتنكيل الأفارقة الذين لم يسلموا من الظلم والإذلال، فقد فجَّر الفرنسيون مجزرة “كبكب” ضد المئات من علماء ومفكري “تشاد” المسلمين الذي بلغ تعدادهم 400 أو يزيد، بعد دعوتهم لاجتماعٍ نقاشيٍّ حول إدارة الأزمة في البلاد، ثم قام الجنود بإغلاق الأبواب وذبحهم عن بكرة أبيهم ودفنهم في حفرةٍ جماعيةٍ في إحدى مناطق مدينة “أبْشة”، بحجة تطهير البلاد من الرجعية الإسلامية التي تفشّت داخلها، والتي كانت كالشوكة في الحلق أمام البعثات التبشيرية المسيحية التي جهّزوا لها. وإذا ذُكرت إفريقيا فبالتأكيد لن نغفل الدور الرئيسي الذي لعبته فرنسا في حرب الإبادة الأهلية في “رواندا”، في أبريل/نيسان 1994، والتي استمرت لثلاثة أشهرٍ، وانتهت -حسب الإحصائيات- بعدد قتلى وصل إلى 800 ألف، أغلبهم من جماعة “التوتسيين”، بعد فائضٍ من الدعم الفرنسي الذي موَّلهم بالأسلحة والعتاد والجنود المرتزقة تحت غطاءٍ دبلوماسيٍّ كاذبٍ. كل ذلك إلى جانب التدخلات المباشرة في شؤون العديد من البلدان الأخرى، كمساعدتهم للصرب في حربهم ضد البوسنة والهرسك، ومساعدة الميليشيات المسلحة من مسيحي إفريقيا ضد المسلمين، وقمع الأفارقة وترحيلهم قسراً في عرض البحر لاستعبادهم واستغلالهم لمصالحهم الشخصية الدنيئة، ومن يعترض أو يتأفف فأسماك القرش أولى به.
هل يمرُّ الإسلام بأزمةٍ فعلاً؟
من العجب العُجاب أن يُطلِق هذا الشعارَ رئيسُ دولةٍ أنشأت أحد أقذر متاحفها وهو “متحف الإنسان”، في باريس عام 1937، والذي تحتفظ فيه بما يقرب من 20 ألف جمجمةٍ لبشرٍ حقيقيين -بعضهم من الجزائريين- تم إرسالها لفرنسا كغنائم عسكريةٍ لترهيب المواطنين من البلدان المحتلة، وكذا المفاخرة بجرائمهم وقوَّتهم الزائفة أمام شعوبهم الأوروبية الحقيرة. تلك الجماجم كانت لأناسٍ يعيشون ويعملون ويتواصلون مع بعضهم البعض كسائر الناس، لكنهم عند الفرنسيين كائناتٌ أخرى لا ترتقي لجنس البشر، فلم يرحموهم في حياتهم ولم يحفظوا آدميتهم بعد مماتهم.
فأين الإسلام من كلّ هذا القتل والعنف والاغتصاب البشع لثروات البلاد وحياة العباد؟ لا ولن تجده، لكنك ستجد “فرنسا” عروس القارة العجوز، والفتاة الفاتنة التي تتحدث بلسانٍ رقيقٍ وبلغةٍ لطيفةٍ تخفي عهر وظلمة باطنها، تأتي الآن لتحاضر وتنظِّر وتدعو العالم لوضع حدٍّ للإسلام لأنه دين الإرهاب -في نظرهم- الذي يدعو لقطيعة الإنسانية والظلم والقتل والتعدي على الشعوب الأخرى. إنما الإسلام أزمته أنه الإسلام، أنه دين الله الحنيف وشرعته الحقَّة في الأرض، أنه ليس ديناً إنسانويّاً متميِّعاً كالذي يدعون إليه، أنه الدين الذي يكفل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر، فيضع السيف على رقبة المعتدي ويضع الخبز في فم المسالم.
إن “ماكرون” وشركاءه من عصبة الزعماء والقادة وحلفائهم -المتعثرين في أحذيتهم خوفاً من فقدان كراسيِّ الحكم في بلادهم- لا يخشون حقيقةً من إرهاب الإسلام المزعوم، إنما يرعبهم تمدد الإسلام وانتشاره بين شعوبهم.
هذه هي الحكاية باختصار.