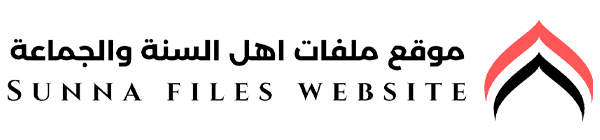تطالعنا وسائل الإعلام على مدار الساعة هذه الأيام بهجوم روسي على أوكرانيا التي تراها جزءاً من تاريخها وأمنها، ولن تقبل تحت أي ظرف أو مبرر انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مشهد تكرر في سوريا وكان أشد دموية وهمجية، وكذلك في ليبيا والقرم وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ومن قبل في الشيشان وداغستان، وكلها مشاهد تنم عن بطش الآلة الروسية ودمويتها تجاه المخالف.
والحق أن هذه السياسة الروسية المعاصرة التي تستخدم القوة الغاشمة لتحقيق مآربها، واستعادة أمجادها الإمبراطورية القديمة على حساب الدول والأمم الضعيفة من حولها، كانت جزءاً من الشخصية الروسية في تاريخها القديم حين كانوا مجرد دويلة صغيرة بين أمم الصقالبة في الغرب وهي الشعوب السلافية في البلقان ووسط أوروبا، والبلغار بالقرب منهم، وكذلك الخزر في القوقاز، فضلاً على المسلمين الأتراك والعرب والإيرانيين في الجنوب حيث أذربيجان وأرمينية وشمال إيران.
بين الوثنية والهمجية
لم يكتب الروس عن تاريخهم المبكر في مرحلته الوثنية قبل دخولهم المسيحية الأرثوذكسية في نهايات القرن العاشر الميلادي؛ إذ كانوا قوماً همجاً -حسب وصف مؤرخي ذلك الزمان-، يعيشون على القتل والدماء والأشلاء، لا يهتدون بدين ولا حضارة، ولا يعرفون قراءة أو ثقافة، وإنما كتب عنهم أشد الناس حضارة، وأوعبهم ثقافة حينذاك وهم المسلمون في عصرهم الذهبي زمن الدولة العباسية، ويحق لنا أن نعود ونستقصي سريعاً نظرة المؤرخين والجغرافيين المسلمين إلى الشعب الروسي آنذاك لنرى جزءاً من تاريخ هذه الأمة.
يخبرنا الجغرافي اللامع ابن حوقل (ت 295 هـ) في موسوعته “صورة الأرض” أن “الروس قوم همج سكّان بناحية بلغار فيما بينهم وبين الصقالبة (الشعوب السلافية) على نهر اتل (الفولجا)”. – ابن حوقل: صورة الأرض 1/15- وقد عملوا في صناعة وتجارة الجلود التي كانوا يتحصلون عليها من حيوانات ذوات الفرو عالي الجودة في بلادهم، فابن حوقل يعود فيؤكد أن “أكثر هذه الجلود وجلّها يوجد في بلد الروس، وينزل إليهم وإلى ناحيتهم مِن ناحية ياجوج وماجوج (وسط آسيا) وقد يصعد إلى بلغار، ولم يزل كذلك إلى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة فإنّ الروس أخربوا بلغار”. – ابن حوقل: السابق 2/392-.
إنه لمن اللافت أن المعلومات التي تقدمها المصادر العربية عن بداية الدولة الروسية تُعتبر في طليعة الآثار عن تاريخ روسيا، بل وتسبق التواريخ الروسية المدونة بحقب تامة، هكذا يعترف كبار المستشرقين والمؤرخين الروس في عصرنا هذا، وعلى رأسهم العلامة إغناطيوس كراتشكوفسكي في كتابه الموسوعي “تاريخ الأدب الجغرافي العربي”، ويشيد كراتشكوفسكي بالرحلة المبهرة التي قام بها مبعوث الخليفة العباسي، الفقيه والسفير والمغامر أحمد بن فضلان بن حماد الذي زار روسيا في حدود سنة 311هـ/922م، وقد كتب ابن فضلان معلومات على قدر من الدقة والموضوعية، وكشف لنا ما كان يرزح فيه المجتمع الروسي القديم قبل ألف ومئة عام في ظلام الجهل والتخلف والوثنية، كما لفت انتباه ابن فضلان صحةُ أبدانهم وقوّتُها؛ يقول ابن فضلان: “ورأيت الروسيّة وقد وافوا في تجارتهم ونزلوا على نهر إتل (الفولجا)، فلم أر أتمّ أبداناً منهم كأنّهم النّخل شُقر حمر.. ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقّيه، ويخرج إحدى يديه منه، ومع كلّ واحد منهم فأس وسيف وسكّين لا يفارقه”. وقد رآهم مغرمين بالوشم والتصوير على أجسادهم.
والحق أن ابن فضلان لم يرتح لهم، وقدم في الروس نقداً لاذعاً؛ لأسباب عدة على رأسها عدم اهتمامهم بالنظافة والطهارة، أو اهتداء بأخلاق أو حياء، قائلاً: “ولا بدّ لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون، وذلك أنّ الجارية توافي كلّ يوم بالغداة ومعها قصعة كبيرة فيها ماء فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه فيغسله ويسرّحه بالمشط في القصعة، ثم يمتخط ويبصق فيها ولا يدع شيئاً من القذر إلا فعله في ذلك الماء، فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه”! – رحلة ابن فضلان-.
كما وصف ابن فضلان حال اجتماعهم في ترحالهم في بيوت كانوا يقيمونها سريعاً من الخشب، وفيها كان يجتمع العشرة والعشرون والأقل والأكثر ومعهم الجواري للبيع، ولكل واحد منهم سرير، فكانوا يضاجعون جواريهم فيما بينهم دون ذرة من حياء أو خجل، كما وصف معبوداتهم الوثنية التي كانت مصنوعة من الصور الخشبية، وتقديمهم الهدايا والقرابين لها لتيسير تجارتهم وبيعهم، كما كان من عادتهم إخراج توابيت موتاهم وهي غضة في أيامها الأولى، فيُخرجون منها جسد الميت، ثم يأتون بجاريته التي تطوعت بالموت معه، فيعدون لهما سفينة في أحد أنهارهم، فيحرقونها في طقوس من السادية، وحفلات من الجنس الجماعي لهذه الفتاة المقبلة بعد قليل إلى الموت.
وقد شاهد ابن فضلان كل ذلك، ورواه بتفاصيل مفزعة، تشبه مشهداً سينمائياً بكل ما في الكلمة من معنى، ورغم كل مشاهد السادية والتعذيب التي كانت تنالها الجارية قبل قتلها مع سيدها المتوفى، كان الروس يفخرون بهذه الطقوس، ويعتبرونها دليلاً على رشدهم وعقلانيتهم، حتى إن أحدهم عاب على العرب والمسلمين طريقة دفنهم موتاهم موجهاً كلامه لابن فضلان: “يقول أنتم معاشر العرب حمقى؛ لأنكم تعمدون إلى أحبّ الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب فتأكله الهوام والدود، ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته”! – رحلة ابن فضلان-.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
دموية الروس
لم يتغير انطباع المسلمين عن الروس كثيراً في القرن التالي، ففي كتاب “حدود العالم من المشرق إلى المغرب” لجغرافي مسلم لم يصلنا اسمه، نراه يقول عن روسيا إنها: “بلاد كبيرة أهلها سيئو الخلق والطباع، نفورون محتالون متمردون مقاتلون، وهم يحاربون جميع الكفار المحيطين بهم وينتصرون عليهم. وملكهم يقال له خاقان الروس. بلاد نعمهم في غاية الوفرة وفيها من كل شيء. وتوجد مروءة لدى فريق منهم. وهم يعظمون الأطباء، ويعطون العُشر من كل غنائمهم وتجاراتهم إلى ملكهم كل سنة” – مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص189-. ويؤكد وصفه ما ذكره ابن فضلان من قبله بنصف قرن حين يقول: “يضعون مع الميت كل شيء كان له من ثياب وحليّ داخل القبر مع طعام وشراب” -مجهول: السابق ص189.-.
وفي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين زاد عدد سكان الروس فيما يبدو من مصادر جغرافية وتاريخية، بل واتضح للمسلمين أن الروس ليسوا شعباً واحداً وإنما هم على ثلاثة أصناف، وهو ما تؤيده الدراسات التاريخية الحديثة التي تؤكد أن الروس لم يكونوا “دولة – الأمة” على مدار تاريخهم، فلم يكونوا من عرق واحد، وإنما جمعتهم أعراق روسية وسلافية وفنلندية وغيرها، ومن مجموعها كوّنوا دولتهم عبر التاريخ.
ويخبرنا الجغرافي البكري ومن سبقه من الجغرافيين المسلمين أن الروس أصبحوا في حدود القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: “في نحو مئة ألف إنسان، وهم يغزون الصقالبة (السلاف في غرب البلقان ووسط أوروبا وشمالها) في السّفن. وبلكار (بلغار) تبع للروس وموافقون لهم. وليس للروس مزارع ولا كسب إلا بسيوفهم، وقيل: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم ينزل ملكهم مدينة كويابة (كييف عاصمة أوكرانيا اليوم وكانت عاصمة الروس قديما) وهي أقرب من بلقار (بلغار) وهم أقرب للروس، وصنف آخر يسمّون الصلاوة، وصنف ثالث يسمّون الأوثانية وملكهم مقيم بأوثان، والتجار إليهم لا يتجاوزون كويابة. فأمّا أوثان فلم يخبر أحد أنّه دخلها لأنّهم يقتلون كلّ من وصل إليهم من الغرباء” – البكري: المسالك والممالك 1/491.-.
وحتى ذلك الحين بقيت طباعهم على شراستها، فهم “لا كسب لهم إلا بسيوفهم” على خلاف جيرانهم من البلغار أو المسلمين أو الصقالبة، وقد وصفهم الجغرافي اللامع ياقوت الحموي في بداية القرن الثالث عشر الميلادي قائلاً إنهم: “مستهترون بالخمر يشربونها ليلاً ونهاراً، وربّما مات الواحد منهم والقدح في يده، وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: من منكم يموت معه؟ فيقول بعضهم: أنا، فإذا قال ذلك فقد وجب عليه لا يستوي له أن يرجع أبداً، ولو أراد ذلك ما ترك، وأكثر ما يفعل هذا الجواري”. -ياقوت الحموي: معجم البلدان 3/81.-.
إذن اشتُهر عن الروس -حسبما كتب العرب قبل نحو ألف سنة- أنهم قوم محاربون، سفاكون للدماء بلا ضمير ولا تردد، وكثيراً ما تطالعنا المصادر التاريخية الإسلامية بهجومهم على كل من حولهم من الأمم والأعراق آنذاك، سواء كانوا من الأمم الوثنية الأوروبية في شمال البحر الأسود الذي كان يُسمى آنذاك ببحر “بنطس” أم المسلمين في جنوب القوقاز وشمال إيران.
وقد نقل الطبري في تاريخه العديد من هجماتهم على أذربيجان وشمال إيران، كما ذكر الحميري في كتابه “الروض المعطار في خبر الأقطار” عن إحدى هذه الغارات الروسية على المناطق الإسلامية في جنوب القوقاز في القرون الهجرية الأولى قوله: “فسفكت الروس الدماء، واستباحت النسوان والولدان، وغنمت أموالاً، وشنت الغارات وأحرقت، فضجّ من حول هذا البحر (بحر قزوين) من الأمم؛ لأنهم لم يكونوا يعهدون في قديم الزمان عدواً يطرقهم فيه، وإنما تختلف فيه مراكب التجار والصيد”.
وظلت هجمات الروس لا ترحم في بحر قزوين، حتى قرر المسلمون في مملكة الخزر اليهودية في القوقاز في حدود القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي -وكانوا يمثلون أعداداً كبيرة في هذه المملكة، ولهم تقديرهم واحترامهم- أن يواجهوا غدر الروس وهجومهم على إخوانهم المسلمين في جنوب بحر قزوين، يقول الجغرافي أبو عبيد البكري: “وكان المسلمون في نحو من خمسة عشر ألفاً بالخيول والعدد، وأقامت الحرب بينهم ثلاثة أيام، ونصر الله المسلمين فأخذهم السيف فمن قتيل وغريق.. وأُحصي من قتلاهم على شاطئ نهر الخزر نحو من ثلاثين ألفاً، ولم يكن للروس من تلك السنة عودة”.
اعتناق المسيحية ومواجهة الإسلام
لم تستمر وثنية الروس كثيراً، ففي نهاية القرن العاشر الميلادي اقتنعوا بالمسيحية، واستقبلوا رُسل الإمبراطور البيزنطي وقساوسته بتقدير وقبول، وصاروا منذ ذلك التاريخ عضداً للبيزنطيين، وقد نقل الجغرافي الكبير ياقوت الحموي في كتابه “معجم البلدان” مقتطفات من رحلة ابن فضلان إلى بلاد روسيا والتي وصلها في حدود عام 310هـ/922م قبل ستين عاماً من دخولهم إلى المسيحية الأرثوذكسية، ومع ذلك لم يفتِ ياقوت الحموي المتوفى في عام 627هـ/1229م أن يؤكد أن ابن فضلان رآهم في حال الوثنية قبل أن يصيروا على النصرانية قائلاً: “هذا ما نقلته من رسالة ابن فضلان حرفاً حرفاً وعليه عُهدة ما حكاه، والله أعلم بصحته، وأمّا الآن فالمشهور من دينهم دين النصرانيّة”. -ياقوت: معجم البلدان 3/83.-.
أما ما يلفت نظرنا أن الروس مذ دخلوا إلى المسيحية فقد انحازوا بكل قوتهم إلى الدولة البيزنطية التي كانت في مواجهة شرسة ضد الإسلام والمسلمين، ولعل أشهر هذه المعارك في تاريخ الإسلام؛ معركة ملاذكرد الفاصلة التي وقعت بين السلاجقة بقيادة السلطان الكبير، والمجاهد الشهير ألب أرسلان السلجوقي سنة 463هـ/1071م وكان معه 15 ألف مقاتل، ضد الدولة البيزنطية بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع الذي كان على رأس 200 ألف مقاتل، وهي المعركة التي أرادها رومانوس فاصلة للقضاء على السلاجقة في مهدهم في العراق والشام والقوقاز، ثم قضى الله أن ينتصر المسلمون وتُفتح الأناضول، ومن رحم السلاجقة يخرج العثمانيون ويفتحون القسطنطينية بعد ذلك بأربعة قرون. واللافت في هذه المعركة أنه عادة ما يغيب عن المؤرخين ذكر العناصر الأخرى التي شاركت في هذه المعركة بقوة وضراوة سواء في صفوف السلاجقة الأتراك، أو البيزنطيين اليونان والسلاف من جانب آخر.
فأما الجانب السلجوقي التركي فقد شارك معهم أكراد أهل خلاط المسلمون وما حولها في شرق الأناضول وقدّرهم بعض المؤرخين الأتراك مثل المؤرخ الكبير عثمان طوران بـ20 ألف كردي من أهالي تلك المناطق، كان لهم أدوار مؤثرة في نصرة الإسلام والمسلمين قبل وبعد المعركة، لأن مشهد القتال قُسّم على عدة مناطق كان أشهرها ملاذكرد التي تقع في أقصى شرق تركيا اليوم في محافظة “موش”.
أما في الجانب البيزنطي فقد شاركت الروس بفلذات أكبادهم، من خلال فرقة عسكرية قوية وكلاهما كما نعرف من أبناء العقيدة الأرثوذكسية، ويخبرنا المؤرخ كمال الدين بن العديم من مؤرخي القرن السابع الهجري في تاريخه المعروف “بُغية الطلب في تاريخ حلب” قائلاً: “أنفذَ السلطان (ألب أرسلان) في مقدمته أحد الحُجّاب، فصادف عند خلاط صليبا (راية كبيرة) تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم، فحاربوهم، وأعطى الله المسلمين النصر عليهم، فأخذ الصليب، وأسر المقدم، وتقارب السلطان، وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة، وكان السلطان في خمسة عشر ألفا، وصاحب الروم في مائتين ألوف” -ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب 4/1979، 1980.-.
وهذا النص التاريخي المهم يكشف لنا إلى أي مدى دافع الروس عن الدولة البيزنطية وأراضي الأناضول، وكانت جزءاً من استراتيجيتهم الدينية والثقافية والعسكرية منذ فترة مبكرة بعد اعتناقهم للمسيحية.
وهكذا رأينا في تاريخ الروس المبكر الذي جمع بين مرحلتي الوثنية ثم المسيحية أوصافاً وسمات أخلاقية واجتماعية يمكن أن نفهم من خلالها طبيعة الشخصية الروسية عبر ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.