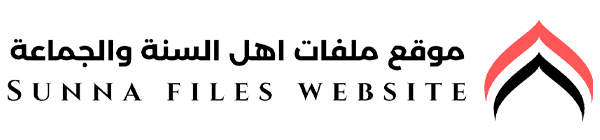تطرح الكثير من الدوائر التي تؤمن بالأفكار الإلحادية، واللاأدرية – وكلاهما أمرٌ مختلف كما سنرى – النهج العقلي مبرِّرًا ومفسِّرًا لما يزعمونه من أفكار وتصورات حول الكون والخلق.
وقد يبدو أن التصدِّي إلى هؤلاء أمرٌ عسير، في ظل عصر سطوة العقل، الذي تحياه البشرية، وتأليهه من جانب البعض، مع تجليات العلم الكبرى، وما حققه الإنسان في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمور العلمية ذات الطبيعة الرمزية في هذا المجال، مثل الجينوم والهندسة الوراثية، وغزو الفضاء وبدء عمليات استيطانه بالمعنى الحرفي للكلمة.
ولكن في حقيقة الأمر، فإن أهم ما يدحض أفكار هؤلاء هو المنهج العقلي ذاته.
وقبل أن نفهم ذلك فإن هناك قضية يجب أن ندركها، ويدركها العاملون في مجال التصدي للأفكار الإلحادية، وهي أن هناك فارقًا وبونًا كبيرَيْن بين الملحدين وبين اللاأدريين.
وهذا الفارق ليس من نافل القول أن يدركه الدعاة والمفكرون العاملون في حقل العمل الإسلامي؛ لأنه يفرض اختلافًا كبيرًا في آليات النقاش مع كلا الفئتَيْن.
فالملحدون، هم فئة حسمت أمرها من قضية وجود الخالق عز وجل، بالإنكار، وبالتالي فإنهم يفسِّرون وجود الكون وتحولاته وتطوراته، من منظور نظريات عدة، مثل المصادفات كما في موضوع شكل الكون ونمط العلاقات والتفاعلات بين مكوناته المختلفة، ونظرية التطور الطبيعي والطفرات في حالة الحديث عن “ظاهرة” الحياة والمخلوقات الحية.
أما اللاأدريون فهم لم يزالوا عند محطة سابقة على ذلك؛ لأنهم يعبِّرون عن موقفهم من مسألة الخلق ووجود الخالق، بأنهم غير قادرين على حسم رأيهم في هذه المسألة، بسبب وجود ما يتعارض عقليًّا مع موقف الملحدين.
ولذلك ليس دقيقًا القول بأن اللاأدريين ملحدون، وأن كلمة “اللاأدري” هذه تعني أنه لا يدري شيئًا عن وجود الخالق. الذي يقول بذلك هو ملحد، أما “اللاأدري” في الاصطلاح، فهو غير القادر على تكوين موقف بعينه من هذه المسألة، وليس بقادر على حسم موقفه منها.
وأقل فئة من بين هذه الفئات، هي فئة اللادينيين؛ لأن هؤلاء يؤمنون بوجود إله واحد، وربٍّ مدبِّر لهذا الكون، ولكنهم لا يعتقدون في أي دينٍ من الديانات الحالية، أو ما يُعرَف في أوساط الناس بالديانات السماوية وهو تعبير غير صحيح إذ ان الدين السماوي الوحيد هو الإسلام، وهؤلاء يمكن الوصول معهم إلى حقيقة الاعتقاد الصحيح من خلال جهد أقل تعقيدًا مما هو مطلوب مع الفئتَيْن السابقتَيْن.
وأهم مرتكزات أفكار الملحدين في مسألة وجود الخالق عز وجل، هي قضية أزلية الكون، وأسئلة على غرار: “مَن خلق الله؟” سبحانه وتعالى عمًّا يصفون.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
وفي نقطة أزلية الكون، أي أنه من دون بداية، شاءت حكمة اللهِ عز وجل، أن تُنقَض أفكار الملحدين في هذا الجانب من خلال العلم ذاته؛ فنظرية “الانفجار العظيم” أو الـ”Big Bang” التي توصل إليها العلماء في الستينيات الماضية، كأساس لخلق الكون على الصورة التي نعرفها في وقتنا الراهن، توضح أن له نقطة بداية، وتنفي عنه صفة الأزلية.
نظرية “الانفجار العظيم” أو الـ”Big Bang” التي توصل إليها العلماء في الستينيات الماضية، كأساس لخلق الكون على الصورة التي نعرفها في وقتنا الراهن، توضح أن له نقطة بداية، وتنفي عنه صفة الأزلية
ثم اتفقت هذه النظرية مع ما جاء في القرآن الكريم بصورة صريحة. يقول تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30].
وعندما توصل العلماء إلى حقيقة أن الكون لا يزال في مرحلة الاتساع، وجدناها في القرآن الكريم. يقول عز وجل: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} [الذاريات: 47].
الأمر الآخر هنا هو أن تعقيد الكون لا يمكن معه بحالٍ إلا أن يكون له صانع . عندما جادل الإمام أبو حنيفة النعمان بعض الملحدين في عصره كان هذا ردَّه. أخبرهم بأنه قد تأخر على موعدهم حتى صنعت المصادفات له قاربًا حمله، فاتهموه بالجنون، فقال لهم ما معناه: كيف تصدقون – إذًا – أن الكون الأكثر تعقيدًا بما لا يُقاس من قارب صغير يمكن أن يُخلَق ويسير بهذا النسق الدقيق، من دون صانع.
وكل ذلك يرد بمنطق الملحدين على الملحدين أنفسهم، الذين يعظِّمون من قيمة العقل ويعلون من مكانة العلم المادي في صياغة أفكارهم وتصوراتهم عن العالم.
ثم نأتي لأهم ما يطرحه الملحدون، ومَن نحو نحوهم مِن تساؤلات حول طبيعة اللهِ عز وجل، لو صحَّ التعبير، وهي قضية خَلْق اللهِ – سبحانه وتعالى عمَّا يقولون – عندما يأتي الحديث عمَّن خَلَقَ الخَلْق فنجيب بأنه الله عز وجل.
في هذه الجزئية بالذات فإن موقف الملحدين غير عقلاني، ولا يتفق مع قواعد المنطق البسيط، بعيدًا عن انتمائنا كمسلمين.
فوفق قواعد العلم ذاته، والمنطق الذي يحكمه لا تجوز مساواة ما ليس بمستوي الطرفَيْن، وهذه قاعدة رياضية بحتة. بمعنى أنه ليس من المنطق تطبيق قاعدة “الخَلْق” على الخالق والمخلوق معًا.
فمسألة أو قضية الخَلْق تتصل بنقطة الإيجاد من العدم، أو الصناعة والتكوين من أمور ومواد أولية كما في المعاني المختلفة لكلمة “الخَلْق” في القرآن الكريم.
فعندما يصنع الإنسان سيارة على سبيل المثال، وهذا في حد ذاته يُعد عملية خَلْق كيان جديد من مواد ومكونات أوليَّة، تختلف في طبيعتها عن طبيعة كل جزء منها على حِدَة، هل علم أحدٌ أن هناك سيارة قد صنعت إنسانًا! أو قادته عبر الطريق! هذا كلام مجافٍ تمامًا للعقل والمنطق.
فالإنسان هنا هو الصانع، والسيارة أداة ركوب، فلذلك عندما “خلقها” الإنسان بمفهوم التكوين والتركيب لأداء مهمة أو وظيفة معينة لا يمكن أن نتصور أن ينطبق على صانعها ذات المنطق.
بنفس المنطق، لا يمكن بحال أن نتساءل عن كيفية خَلْق الخالق؛ لأنها مسألة غير منطقية في الأصل، وفق المعنى العلمي لمصطلح “مسألة” في مجال المنطق. أي أنها عبارة عن أمر لا تجوز منطقته أو طرحه للتساؤل في سياق معادلة منطقية نبحث لها عن إجابة أو حلٍّ من الأصل.
لا يمكن بحال أن نتساءل عن كيفية خَلْق الخالق؛ لأنها مسألة غير منطقية في الأصل، وفق المعنى العلمي لمصطلح “مسألة” في مجال المنطق. أي أنها عبارة عن أمر لا تجوز منطقته أو طرحه للتساؤل في سياق معادلة منطقية نبحث لها عن إجابة أو حلٍّ من الأصل
وهذا الأمر متفقٌ عليه عقليًّا منذ عصر ما قبل الرسالات. فهناك الكثير من القبائل البدائية في أدغال أفريقيا، وحضارات قديمة في أمريكا الجنوبية، عُثِرَ على مدونات ومرويات تؤكد توصلهم إلى حقيقة وجود إله أو ربٍّ خالقٍ ومدبِّرٍ لهذا الكون. أيًّا كانت طبيعة الإله الذي عبدوه أو الرَّبِّ الذي تصوروه.
وهنا تكمن أهمية دراسة هذه المسألة أنثروبولوجيًّا من جانب الدعاة وعلماء المسلمين؛ فأيًّا كانت صورة الإله أو الرب الذي تصورته هذه القبائل، وعبدته هذه الحضارات، ولكن المهم أنهم توصلوا بصورة عقلية بحتة – من دون رسالات من لدن اللهِ عز وجل – إلى أن هناك خالقًا مدبِّرًا لهذا الكون، وأنه واحد لا شبيه ولا مثيل له.
وهذا يتوافق مع منطق قرآني عقلي وواضح محكم، وهي قاعدة: “إذًا لذهب كل إلهٍ بما خلق”، و”لعلا بعضهم على بعض”. يقول تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91].
أما قضية إثبات أن هذا الإله والربُّ الواحد الذي تصورته هذه الحضارات، وتلك القبائل، هو رب العزة سبحانه، الله الواحد الأحد الذي نعبده كمسلمين، ونجده في الرسالات المتداولة في أيامنا هذه؛ فهو أمرٌ في غاية السهولة في ظل الصورة المحكمة القويمة التي قدمها القرآن الكريم عن اللهِ تعالى، وعن أسمائه وصفاته؛ فهي أكمل صورة، وأكثر صورة منطقية يمكن أن يكون عليها رب وخالق هذا الكون.
الإسلام والقرآن الكريم، وصحيح الكتب السابقة على القرآن الكريم قبل تحريفها، تقدم صورة سليمة للإله والربِّ الخالق القيوم، فلا نجد أي اعوجاج أو عوارض له، أو أن يطرأ عليه تغيير، أو أي شيء من السفاهات التي نجدها في تصور الديانات الوثنية للإله الخالق
فالإسلام والقرآن الكريم، وصحيح الكتب السابقة على القرآن الكريم قبل تحريفها، تقدم صورة سليمة للإله والربِّ الخالق القيوم، فلا نجد أي اعوجاج أو عوارض له، أو أن يطرأ عليه تغيير، أو أي شيء من السفاهات التي نجدها في تصور الديانات الوثنية للإله الخالق.
وبعيدًا عن اعتقادنا كمسلمين، فإنه من المنطقي والبديهي أن يكون الإله والرب الخالق، واحدًا، كاملاً، لا يعتريه ضعف، ولا تسري عليه قواعد الزمن الذي هو مخلوق في حد ذاته، فلا يمكن للأدنى أن ينطبق على الأعلى، وهذه بدورها معادلة عقلية منطقية وسليمة.
وفي الأخير، فإن المنهج العقلي الذي يستند إليه الملحدون والمنكرون لفكرة وجود صانعٍ لهذا الكون، هو أهم مِعْوَل يمكن أن يتم الاستناد إليه لهدم أفكارهم ، ولكن ذلك لن يكون – مثل منهج فهم القرآن الكريم – من دون تدبُّر وفهم من جانب العاملين في هذا الحقل.