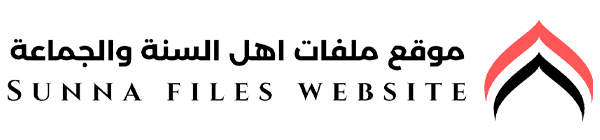كثيرًا ما يتم تقديم تاريخ الأمة الأمريكية الحديثة، بالاستناد إلى رواية بروتستانتيّة تحرم الجماعات الأخرى من أي اعترافٍ بدورها في إنشاء الولايات المتحدة الحديثة، عبر صهر التاريخ الأمريكي كلّه وتقديمه كحرب بين البروتستانت والكاثوليك ومن ثمّ الأمريكيين البيض والهنود، الذين تخبرنا المادّة في أدناه، أنّهم أنفسهم كانوا أسيادًا للعبيد في مزارع السكّر، وأنهم أيضا استعبدوا الأفارقة على غرار البيض وبالتنسيق معهم. غير أنَّ الناحية الأكثر جِدَّة في هذا كله، أنّ هؤلاء العبيد كانوا في غالبيتهم من المسلمين، وقد حُرِموا حريّتهم، وحريّة ممارسة شعائرهم، وفي بعض الحالات نُصّروا بالقوّة وحرموا من أي انتماء للإسلام أو العروبة. وبأنهم كانوا متعلّمين وأطباء وأمراء في بلدانهم الأم.
تتناول المادّة التالية حكاية هذا التحويل والحذف، عبر ثلاث حكايات لثلاث شخصيّات مسلمة بارزة، انقلبت حياتها بين عشيّة وضحاها، وتحوّلت مكرهة إلى أشياء هي ليست عليها في ذروة الاستعباد الأوروبي.
جاءت أولى الكلمات التي ستعبُر بين الأوروبيين وسكّان أميركا (بقدر ما يبدو الأمر منحازًا ومحيِّرا) من لغة الإسلام. كان كريستوفر كولومبوس يأمَل في الإبحار إلى آسيا، وتجهّز للتواصل مع حاشيتها المهيبةِ باللجوء إلى واحدة من أعظم اللغات في التجارة الأوراسيَّة. لذا عندما خاطب مُترجم كولومبوس، وقد كان سفارديّا أندلسيًّا، تاينو الكاريبي، قام بذلك مستخدمًا اللغة العربية. ليست لغةُ الإسلامِ فحسب، بل إنَّ الديانة ذاتها على الأرجح وصلت أمريكا عام 1492 للميلاد، أيّ قبل 20 عامًا على قيام مارتن لوثر بتثبيت أطروحتِه على باب [الكنيسة]، بادئًا الإصلاح البروتستانتي.
فتح المور – المسلمون أفارقًة وعربًا – معظم شبه الجزيرة الإيبيريَّة عام 711 للميلاد، مؤسسين لثقافة إسلامية دامت زهاء ثمانية قرون. مع بداية عام 1492 للميلاد، اختتم الملوك الإسبان فرديناند وإيزابيلَّا [حروب] الرِّيكونكويستا (الاسترداد)، بهزيمة آخر الممالك المسلمة، مملكة غرناطة. وبحلول نهاية ذلك القرن، كانت محاكم التفتيش، التي بدأت قبل قرن واحد، قد أكرهت نحو 300.00 إلى 800.00 مسلم (ونحو 70.000 يهودي على الأقل) على اعتناق المسيحية. عادةً ما كان الكاثوليك الإسبان يشتبهون بممارسة أولئك الموريسكييّن أو الكونفيرسوس (المتحوّلين) للإسلام (أو اليهوديّة) سرًّا، فقامت محاكم التفتيش بملاحقتهم ومحاكمتهم. كان بعض هؤلاء، وبصورةٍ شبه مؤكَّدة، قد أبحر ضمن طاقم كولومبوس، حاملين الإسلام في عقولهم وأفئدتهم.
تركت ثمانية قرونٍ من الحكم الإسلامي لإسبانيا إرثا ثقافيًّا راسخًا، تتضح معالمُه بطرق واضحة وأحيانًا مدهشة خلال الفتح الإسبانيّ لأمريكا. وكان بيرنال دياز ديل كاستيّو، مؤرّخُ فتح هرنان كورتيز لأمريكا الوسطى، معجبًا بأزياء الراقصات الأميركيّات فكتب يقول: “كُنّ جميلاتُ الملبس بأسلوبهنّ الخاص، ولقَد بَدوْنَ شبيهاتٍ بالنساء الموريَّات“.
درج الإسبانُ على استخدام لفظة ميزكيتا (مسجد) في الإشارة إلى المواقع الدينية للأمريكيين الأصليين. وفي سفره عبر الأناهواك (ما تُعرف اليوم على أنَّها تكساس والمكسيك)، أفاد كورتيز بأنه رأى ما يزيدُ على 400 مسجد.
كان الإسلام بمثابة نوعٍ من المخطط التفصيليّ أو الخوارزميّة للإسبان في “العالم الجديد”. وبمُلاقاتِهم أناسا وأشياء جُدد عليهم كلَّ الجدّة، لجأ الإسبان إلى الإسلام لمحاولة فهم ما يرونه، وما كان يحدث. حتّى إنَّ اسم “كاليفورنيا” قد يكون له أصل عربي ما. فقد قام الإسبان بإطلاق الاسم، في عام 1535 للميلاد، باقتباسهِ عن “مغامرات الإسبان” (The Deeds of Esplandian) الصّادرة عام 1510 للميلاد، وهي رواية رومانسية تعجُّ بالـ “كونكيستدوريس” (المستكتشفين). والرّواية تتناول جزيرة غنيّة – كاليفورنيا – يحكُمها الأمازونيّون وملكَتُهُم كالافيا. نُشرت الرواية في إشبيليّة، المدينة التي قضت أربعة قرونٍ من الزَّمن كجزء من الخلافة الأمويّة (خليفَة، كالافيا، كاليفورنيا).
على امتداد نصف الأرض من الجهة الغربية، أينما كانت الأراضي الجديدة التي وطئها أو السكّان الأصليين الذين صادفوهم، كانَ المستكشفون يقومون بتلاوة الـ “ريكويرمنتو” (الشَّرط)، وهو إعلانٌ قضائيٌّ منمَّق. كان في جوهره، إعلانًا عن طورٍ جديد من المجتمع: بتقديم الفرصة للأمريكيين الأصليين للتحوّل إلى المسيحيّة والخضوع للحكم الإسباني، وإلا كان عليهم تحمّل مسؤولية كل “الميتات والخسائر” النَّاجمة. الإعلان الرسمي والعلنيّ عن نيّة الفتح، بما يتضمنّه من عرض على غير المؤمنين بالاستسلام والتحوّل إلى مؤمنين، هو أوّل شرطٍ من الشروط الرسميّة للجهاد في الإسلام. وبعد قرونٍ من الحروب مع المُسلمين، تبنّى الإسبان هذه الممارسة، وأضفوا عليها طابعًا مسيحيا، مطلقين عليها اسم الـ “ريكويرمنتو”، ثمَّ أدخلوها إلى أمريكا. ربَّما اعتقد مسيحيّو أيبيريا بأنَّ الإسلام خطيئة، أو شيطنة، لكنَّهُم أيضًا عرفوه جيدا. وإن اعتقدوا بأنه غريب، فلا بدَّ من أنها كانت غرابة من النوع المألوف جدًّا.
بحلول عام 1503 للميلاد، نعرف بأنَّ المسلمين أنفسهم، من غرب إفريقيا وطئوا أرض “العالم الجديد”. في تلك السَّنة، كتب الحاكم الملكيّ لأمريكا الوسطى إلى إيزابيلا يطلب منها خفض الأعداد المستوردة منهم. ذلك أنهم كانوا، كما أشار، “فضيحةً للهنود”. فقد كانوا، على حد تعبيره، كثيرًا ما “يفرّون من مالكيهم”. وفي صبيحة رأس السَّنة من عام 1522 للميلاد، اندلعت أولى انتفاضات العبيد في العالم الجديد، عندما ثار 20 عبدًا من أمريكا الوسطى في مزارع السكّر وشرعوا بقتل الإسبان. وكان الثوّار، كما أشار الحاكم، في غالبيّتهم من الولوفييّن، وهُم شعبٌّ سنغاليّ غامبيّ، بدأ العديد منهم باعتناق الإسلام منذ القرن الحادي عشر. وقد غلب على المسلمين أكثر من غيرهم إجادة القراءة والكتابة: وهي قدرة قلّما نُظر إليها كأفضلية من قبل مُلاك المزارع. وفي العقود الخمسة التي تلت ثورة العبيد في أمريكا الوسطى، أصدرت إسبانيا خمسة مراسيم تحظُر استيراد العبيد المسلمين.
بالتالي فقد وطئ المسلمون أمريكا قبل أكثرِ من قرنٍ على قيام شركة فيرجينيا بتأسيس مستعمرة جيمستاون عام 1607 للميلاد. وقبل أكثر من قرنٍ على قيام البيوريتانيين بتأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس عام 1630 للميلاد. وقد عاش المسلمون في أمريكا ليس قبل البروتستانتيين فحسب، ولكن قبل أن توجد البروتستانتيّة نفسها. وبعد الكاثوليكيّة، كان الإسلام ثاني أكبر الأديان التوحيديّة انتشارا في القارتين.
إنَّ سوء الفهم السائد، حتى في أوساط المتعلمين، بأن الإسلام والمسلمين إضافاتٌ جديدة على أمريكا يخبرنا بأشياء مهمّة عن كيفيّة كتابة التاريخ الأميركيّ. وبالتحديد، فإنه يبيّن كيف برر المؤرخون، وعمموا، ظهور الدولة القوميَّة الحديثة. لقد جاءت إحدى الطرق في الاحتفاء بالولايات المتحدّة الأمريكية عبر الحد من تنوّع ونطاق – الكوزموبوليتانيّة، أو التنوّع والتعايش المشترك بين الأفراد – أمريكَا خلال الأعوام الـ 300 الأولى على الوجود الأوروبيّ.
لقد هيمنت على كتابة التاريخ الأمريكي المؤسسات البيوريتانيّة. وقد لا يكون من الصّحة بمكان، كما اشتكى المؤّرخ (والجنوبي) يو. بي. فيليبس قبل أكثر من مئة عام مضت، القول بأنَّ بوسطن كتبت تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها كتبته بصورة كبيرة على نحو خاطئ. لكن فيما يتعلّق بتاريخ الأديان في أمريكا، فقد كانت عواقب هيمنة المؤسسات البيوريتانيّة الرائدة في بوسطن (جامعة هارفارد) ونيوهافِن (جامعة يال) وخيمة جدا. هذا “التأثير البيوريتاني” على رؤية وفهم الأديان في أمريكا المبكّرة (وأصول الولايات المتحدَّة) يؤدي إلى إحداث تشويه فعلي: كما لو أننا نسلِّم التاريخ السياسيّ لأوروبا القرن العشرين إلى التروتسكيين.
فلنفكّر في التّاريخ على أنه عُمق وانتشار التجربة الإنسانيّة، كما وقعت تماما. فالتاريخ يجعل العالم، أو المكان والأفراد، ما هُم عليه. وعلى العكس، فلنفكّر في الماضي على أنّه تلك القطع والقصاصات من التَّاريخ التي يختارها مجتمع من المجتمعات بغية إقرار نفسه، وتوكيد أشكال حُكمه، ومؤسساته وأخلاقيَّاته السائدة.
نسيانُ المسلمين الأوائل في أمريكا هو، إذن، يتجاوز كونه مسألة غامضة. ذلك أن عواقبه تحمل أثرًا مباشرًا على جوهر الانتماء السياسيّ اليوم. فالأمم ليست أضرحةً أو صناديق لحفظ الموتى والأشياء. إنَّها عضويّة Organic من باب، أنَّه مثلما يجري تشييدها، فينبغي أن تتم إعادة تشييدها باستمرار، وإلا ضَعُفَت وماتت. الاحتكار العملي الذي قامت به الأنجلو بروتستانتيّة لتاريخ الدين في الولايات المتحدَّة حجب نصفَ ألفيَّةٍ من وجود المسلمين في أمريكا وجعل من الصّعب تلمُّسَ إجاباتٍ واضحة عن أسئلة مهمّة بشأن من ذلك الذي ينتمي، ومن هو الأميركي، وبأي معيار، ولمن يكون القرار.
ما الذي يجب أن تعنيه “أميركا” أو “أميركي”؟ من خلال برنامجها “أميركا باكرة، شاسعة”، تشير أوموهوندرو، المؤسسة البحثية الرائدة في التاريخ الأميركيّ المبكّر، إلى إجابة واحدة محتملة: إن كلا “أميركا المبكّرة” و”أميركي” هما مصطلحان كبيران وفضفاضان، لكن ليس إلى درجة أن يكونا عديميّ المعنى تقريبا.
تاريخيًّا، يُمكن أن يُفهمَا على أفضل وجه كتصادم ضخم، كتمازجٍ وفتح لشعوب وحضارات، (وحيوانات وميكروبات) بين أوروبا وإفريقيا وبين شعوب ومجتمعات نصف الكرة الأرضية الغربي، من الكاريبي الكبير إلى كندا، بدأ في عام 1492 للميلاد. ومن عام 1492 حتى عام 1800 للميلاد على الأقلّ، كانت أمريكا، ببساطة، تُعرَّفُ على أنَّها أمريكا العظمى، أو أمريكا المبكّرة، الشاسعة.
كان المسلمون جزءًا من أمريكا العظمى من البداية، بما فيها تلك الأجزاء التي أضحت تعرف بالولايات المتحدَّة. في عام 1527 للميلاد، وصل مصطفى الزمّوري، وهو مسلمٌ عربي من الساحل المغربي، إلى فلوريدا كعبدٍ في بعثةٍ إسبانيّة تعرَّضت للتدمير بقيادة بانفيلو دي نارفيز. على عكس كل الاحتمالات، تمكن الزمّوري من النجاة وأسس لنفسه حياةً، مرتحلا من سواحل خليج المكسيك إلى أنحاء ما يُعرف الآن بجنوب غرب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أمريكا الوسطى. وقد ناضل كعبدٍ للسكّان الأصليين قبل أن يؤسس لنفسه كطبيب معروف له احترامه.
في عام 1542 للميلاد، كان كابيزا دي فاكا، أحدُ أربعة ناجين على متن بعثة نارفيز، قد نشر أول كتاب أوروبي له، عُرف لاحقًا بعنوان “مغامرات في الجوف الخفيّ لأمريكا”، (Adventures in the Unknown Interior of America) والذي كرّسه لأمريكا الشمالية. تحدث دي فاكا عن الكوارث التي نزلت بالمستكشفين، والسَّنوات الثمان التي قضاها النَّاجون هائمين في أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. مُقرًّا بأنَّ الزمّوري كان غير قابل للتعويض، بالقول: “لقد كان هو الزنجي الذي خاطبهم جميعًا طيلة الوقت“.
هذه الـ “هُم” عائدة على السكَّان الأصلييّن، ولقد كانت براعة الزمّوري مع لغات الساكنين الأصليين هي التي حفظت أرواحهم، وأتاحت لهم، بعد فترة من الوقت، درجةً من الازدهار.
لقد رأى الزموري من الولايات المتحدة الحالية، بأراضيها وأناسها، أكثر مما رأى أيٌّ من “الآباء المؤسسين” للبلاد – بل أكثرَ مما رأت أي مجموعةٍ منهم مجتمعة. وتلتقط ليلى العلمي كل هذا وأكثر في روايتها الرفيعة “ما رواه المغربي”(The Moor’s Account) الصَّادرة عام 2014، والتي تتتبَّع فيها رحلة الزَّموري خلال طفولته في المغرب، واستعباده في إسبانيا، ومن ثمَّ نهايته الغامضة في الجنوب الغربي الأميركيّ. إنْ كان ثمة ما يمكن القول بأنه أفضل نسخة من الرواد الأميركيين أو الروح الأُفق، أو شيء من التجربة المترددة الصدى عن التكيُّف وإعادة اختراع [الذات] التي يُمكن أن تدمغ أمّةً من الأمم أو شعبًا من الشعوب، سيكون من الصَّعب أن نجد شخصًا يمثّل هذه الأمور على نحو أفضل مما فعل مصطفى الزمّوري.
بين عاميّ 1675 و1700 للميلاد، مكّنت بدايات المجتمع الزّراعي في تشيسابيك سادة العبيد المحليين من جلب أكثر من 6000 إفريقيّ إلى فيرجينيا وماريلاند. هذه الطفرة في التّجارة دفعت إلى تغيير مهمّ في الحياة الأمريكية. ففي عام 1668 للميلاد، تخطّت أعداد الخدم البِيض في تشيسابيك أعداد العبيد السود بخمسةٍ إلى واحد. لكن بحلول عام 1700 للميلاد، انعكست النسبة. وعلى مدار العقود الأربعة الأولى من القرن الثامن عشر، جاء المزيد من الأفارقة إلى تشيسابيك. وبين عامي 1700 و1710 للميلاد، أدت الثروة الزراعية المتنامية إلى استيراد 8000 أفريقي آخر. ثمَّ بحلول ثلاثينات القرن الثامن عشر، جاء 2000 عبدٍ إضافيّ، على الأقلّ، إلى تشيسابيك. وكانت تشيسابيك الأميركيّة تتحوّل من مجتمع مع العبيد (ومعظم المجتمعات في التَّاريخ الإنسانيّ اقتنت العبيد) إلى مجتمع من العبيد، وهو أمرٌ أغرب من المعتاد. في مجتمع من العبيد، تكون العبوديّة هي عمود الحياة الاقتصادية بينما تكون علاقة العبد بالسيد نموذجا لعلاقة اجتماعية، يسير عليه البقية.
انتشر بين الأجيال الأولى من الأفارقة الذين جيء بهم إلى أمريكا الشمالية العمل في الحقول المحاذية والنوم تحت أسقف مالكيهم. وقد غلب عليهم، كما يلاحظ المؤرّخ إيرا برلين في كتابه “العديد من الآلاف رحلوا” (Many Thousands Gone) الصَّادر عام 1998، توق شديد للتحوّل إلى المسيحية. أملا بأنْ يُساعدهم ذلك في تأمين مقامٍ اجتماعي ما. أما في حالة الغرب إفريقيين الذين أُحضروا في أواخر القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن عشر للعمل عبيدًا في فيرجينيا، ماريلاند والكارولينيّتيْن فقد جاؤوا إما من أجزاء متفرّقة في إفريقيا، أو من جزر الهند الغربية، مقارنةً بأجيال “الميثاق” السابقة. وكانوا أكثر أرجحية لأن يكونوا من المسلمين، وأقل أرجحية بكثير للانحدار من سلالة مختلطة. وقد تذمّر التبشيريّون المسيحيّون والمزارعون في القرن الثامن عشر من أنَّ “جيل المزارعين” من العبيد يُظهر قليلا من الاهتمام بالمسيحيّة. وقد انتقد التبشيريون والمزارعون ما رأوه من ممارسة بعض العبيد “طقوسا وثنية”، وهو ما مكَّن الإسلام، إلى حد ما، من البقاء في مزارع مجتمع العبيد الأمريكي.
وبالمثل، استفاد الفرنسيون، بين عامي 1719 و1731 للميلاد، من الحرب الأهلية في غرب أفريقيا في استعباد الآلاف، جالبين 6000 أفريقي رأسًا إلى لويزيانا. جاء معظمهم من فوتا تورو، وهي منطقة تقع قرب نهر السنغال وتُباعد بين ما تُعرفان حاليا على أنهما السنغال وموريتانيا. دخل الإسلامُ فوتا تورو في القرن الحادي عشر. ومنذ ذلك الحين، عُرفت بكثرة مفكّريها، وجيوشها المجاهدة، وحكوماتها الدينيّة، بما فيها “إمامة فوتا تورو”، وهي حكومة دينيّة قامت ما بين عامي 1776 و1861 للميلاد. كما أنَّ الصّراعات الأفريقية ما بين أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر في “ساحل الذَهب” (ما يُعرف اليوم بـ غانا) وأرض الهوسا (ما يُشكّل في غالبه نيجيريا اليوم) قد انعكست أصداؤها على أميركا. ففي الأُولى تمكن الأشانتي من هزيمة تحالف المسلمين الأفارقة. وفي الأخيرة، انتصر الجهاديّون في النهاية لكنّهم فقدوا في أثناء ذلك العديد من أبنائهم لصالح تجارة العبيد والغرب.
أيوب سليمان ديالو هو أحد أكثر المسلمين شهرة في أمريكا الشمالية القرن الثامن عشر. لقد كان من الفولانيين، وهُم جماعة مسلمة من غرب إفريقيا. مع بداية القرن السادس عشر، قام التّجار الأوروبيّون باستعبادِ العديد من الفولانيين، وإرسالهم لكي يُباعوا في أمريكا. وُلد ديالو في بوندو، وهي منطقة تقع في محيط أنهار السنغال وغامبيا، تحت حكومة دينيّة إسلاميّة. وتم أسره على يد تاجر عبيد بريطاني عام 1731 للميلاد، ثم انتهى به المطاف لأن يُباع إلى مالك عبيد في ماريلاند. تمكّنت بعثة إنجيلية من تمييز كتابة ديالو بالعربية وعرضت عليه النبيذ لكي تختبر إسلامه. لاحقا، قام محامٍ بريطانيّ كان قد كتب إفادة ديالو عن استعباده وانتقاله إلى ماريلاند بأنكلة اسمه الأوّل ليصير “جوب” واسمه الثاني إلى “بن سولومون”. بهذه الطريقة، أصبح أيوب سليمان “جوب بن سولومون”.
بهذه الطريقة، شهدت تجربة الاستعباد والعبور إلى أمريكا “أنكلة” العديد من الأسماء العربية، حيث تحوّلت الأسماء القرآنية إلى شيء مألوف في إنجيل الملك جيمس. موسى أصبح موزس، وإبراهيم أصبح أبراهام، وأيوب أصبح جوب، وداوود أصبح ديفيد، وسليمان أصبح سولمون، وهلمجرّا. وقد اعتمدت توني موريسون على تاريخ ممارسات التسمية الإسلامية في أمريكا في روايتها “أغنية سولومون” (Song of Solomon) الصَّادرة عام 1977. وعنوان الرواية مشتق من أغنية فلكوريّة تحمل في طيّاتها دلائل تشير إلى تاريخ البطل، “ميلكمان ديد” (Milkman Dead)، وأسرته. حيث تبدأ الجملة الرابعة من الأغنية قائلة: “سولومون ورينا، بلالي، شالوت/ ياروبا، مدينا، وكذلك محمِّت“
- سولومون: سليمان
- بلالي: بلال
- شالوت: جالوت
- محمت: محمد
هذه الأسماء جاءت من المسلمين الأفارقة الذين استُعبدوا في فيرجينيا، وماريلاند، وكنتاكي، والكارولينيتين وفي أماكن أخرى من أمريكا. لقد كانت “أغنية سولومون”، بكلمات أخرى، (ولعلّها كانت في أول الأمر) أغنية سليمان.
كانت إعادة تسمية العبيد (أحيانًا بصفاتٍ احتقاريّة أو تهريجيّة) أداةً مهمّة للسلطات الزراعية، ونادرًا ما تم إغفالها. غير أن الأسماء العربية، على امتداد أمريكا الشمالية، حُفظت كجزء من السِّجل التاريخي. فسجلّات المحاكم في لويزيانا للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُظهر إجراءات ترتبط بالمنصور، شومان، عماد، فاطمة، ياسين، موسى، بكري، معمري وآخرين. بينما تفصّل سجلات المحاكم من القرن التاسع عشر في جورجيا إجراءات قانونيّة تتضمن سليم، بلال، فاطمة، إسماعيل، عليق، موسى وآخرين. وقضى نيوبل باكيت، عالم اجتماع من القرن العشرين، حياته يجمع مادة إثنوغرافيّة حول الحياة الثقافية للأميركيين الأفارقة. وفي كتابه “أسماء سوداء في أمريكا: أصول واستخدامات” (Black Names in America: Origins and Usage) يوثّق باكيت أكثر من 150 اسمًا عربيا شائعًا في أوساط أولئك المنحدرين من أصل إفريقي في الجنوب الأمريكي. في بعض الأحيان كان يُمكن أن يحمل الفرد الواحد اسما إنجيليا أو “اسم عبد” لغايات رسميّة، مع انتصار الاسم العربي في الممارسة [اليومية].
من الصّعب معرفة مدى استمرار أسماء عربية ترتبط بممارسة دينيّة أو هويّة مستمرّتين، لكن حدوث انقطاع كلّي يبدو أمرًا مستبعدًا. حيث يقول إعلان بصحيفة من جورجيا يعود لعام 1791 للميلاد حول عبدٍ هارب، على سبيل المثال:
“حارس زنجي جديد، يُدعى جفراي … أو إبراهيم“.
بالنظر إلى السيطرة المحكمة التي مارسها ملّاك العبيد في التسمية، فلا بُدَّ من أنه كان هناك العديد ممَّن يُدعون جفراي والذين كانوا في الحقيقة “إبراهيم”، والعديد من النِّسوة اللائي دُعين “ميسي” وكُنَّ في الحقيقة “معصومة”، وهلمجرًّا.
كان لورينزو داو تيرنر، باحث من منتصف القرن العشرين في لغة الغالا (وهي لغة محكيّة كريوليّة في منطقة “سي آيلاندز” على الساحل الجنوبي الشَّرقي الأميركي) قد وثَّق “نحو 150 اسمًا ذات أصول عربية” كانت شائعة نسبيًا في منطقة سي آيلاندز وحدها. وهي تتضمن أكبر، علي، أمينة، حامد، والعديد من الأسماء الأخرى. وفي مزارع تعود إلى بداية القرن التَّاسع عشر في الكارولينيتين، كان مصطفى اسمًا رائجا. الأسماء العربية لا تجعل المرء مسلمًا بالضرورة، على الأقل ليس في المغرب أو بلاد الشام، حيث العرب مسيحيّون ويهودٌ أيضا. لكنّه كان انتشار الإسلام الذي جلب الأسماء العربيّة إلى غرب إفريقيا. لذا فقد كان هؤلاء الأفارقة أو الأفارقة الأميركيين من أمينة وأكبر، أو على الأقل آباءهم أو أجدادهم، من المسلمين بصورة شبه مؤكّدة.
انطلاقا من خوفها، حاولت السلطات الإسبانيّة حظر العبيد المسلمين من مستوطناتها الأميركيّة المبكّرة. أما في مجتمع العبيد الأنجلو أمريكي الأكثر تماسكا وأمنًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فقد كانوا محل تفضيل العديد من المزارعين. إنمَّا في الحالتين، كان الاستخلاص ذاته: لقد كان المسلمون متميّزين، فقد حازوا السلطة، ومارسوا التأثير. أحد المنشورات – “القواعد العمليّة للإدارة والمعالجة الطبيّة للعبيد الزنوج في مستعمرات السكّر” الصّادر عام 1813 للميلاد، والذي ركّز على جزر الهند الغربية – أشار بأن المسلمين “ممتازون في الاعتناء بالمواشي والخيول، وللخدمة الدَّاخليّة” لكن “لديهم القليل من المؤهلات للأشغال الأكثر خشونة في الحقول، ولهذا السبب لا ينبغي أبدًا استعمالهم”. ويشير المؤلف بأنّه في تلك المزارع: “الكثيرُ منهم يتحادثون باستخدام اللغة العربية”.
كان أحد ملاك العبيد في بداية القرن التاسع عشر في جورجيا والذي زعم بأنَّه يمّثل مقاربة متنوّرة للعبودية قد دعم فكرة تحويل “أساتذة الدّين المحمّدي” إلى “موجّهين، أو زنوج مؤثرين” في المزارع. زاعمًا بأنّهُم سيُبدون “النزاهة لأسيادهم”. وقد استشهد هو وآخرون بحالات كان العبيد المسلمون فيها يصطفّون مع الأمريكيين، ضد البريطانيين، في حرب عام 1812.
وقد كان بعض العبيد المسلمين في أمريكا القرن التاسع عشر أنفسهم ملاكا للعبيد، معلّمين أو ضباطا في الجيش في أفريقيا. حيث كان إبراهيم عبد الرحمن عقيدًا في جيش أبيه، إبراهيم شاه السوري، الأمير الحاكم في فوتا جالون، التي تعرف اليوم بـ غينيا. في عام 1788 للميلاد، وفي عمر 26 عامًا، تم أسر عبد الرحمن في الحرب، وشراؤه من قبل تجّار بريطانيين، ومن ثمَّ نقله إلى أمريكا. قضى عبد الرحمن نحو 40 سنة يلتقط القطن في ناتشيز، المسيسبي. وكان توماس فوستر، مالكُه، يناديه بـ “الأمير” (Prince).
في عام 1826 للميلاد، وخلال سلسلة غير متوقعة من الأحداث، نال عبد الرحمن اهتمام “جمعية الاستعمار الأميركية” (ACS). وقد نُظمت هذه الجمعية بهدف ترحيل الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية من الولايات المتحدة و”إعادتهم” إلى إفريقيا. وبما أنها ضمت عديدًا من المحسنين البارزين في البلاد وبعض أقوى سياسييها، قامت جمعية الاستعمار الأمريكية على مزج أشكالٍ من القومية البيضاء بالمسيحية الكونية. ولأكثر من عامين، مارست الجمعية ضغوطها على فوستر، الذي وافق في النهاية على إعتاق عبد الرَّحمن لكنّه رفض إعتاق عائلته. في محاولة لجمع المال لشراء حريّة عائلته، ذهب عبد الرحمن إلى المدن الحرة في شمال الولايات المتحدة، حيث جال في مناسبات واحتفالات التبرّع – مرتديا الزيّ الموريّ وكاتبًا [سورة] الفاتحة، من القرآن [الكريم] على قصاصات من الورق للمتبرّعين (دافعًا إياهم للاعتقاد بأنَّها الصَّلاة الربيّة).
كان عبد الرحمن مسلمًا يؤدي صلواته كشخص مسلم. وعندما التقى بقادة الجمعية الاستعمارية الأميركية، أخبرهم بأنه كان مسلمًا. لكن توماس جالوديت، وهو إنجيلي بارز درس في جامعة يال وكان ناشطا في مجال التعليم، أعطى عبد الرحمن نسخة عربيةً من الكتاب المقدًّس وطلب إليه الصلاة معه. لاحقا، وأملا بإمكانيّة الانتقال إلى إفريقيا والحصول على وظيفة مجدية، قام أرثر تابان، وهو مُحسن أميركي بارز، بممارسة ضغوط على عبد الرحمن لكي يصبح مبشرا مسيحيا ويُساعده في بسط تأثير الإمبراطورية التجاريّة الرابحة للأخوة تابان إلى إفريقيا.
وقد وصفت “مجلّة الخزان الإفريقي والاستعمار” (The African Repository and Colonial Journal) كيف أنَّ عبد الرّحمن “سيصبح رائدًا أوّل للحضارة إلى إفريقيا غير المتنوّرة”. لقد رأوه يغرس “صليب المخلّص فوق أعالي الجبال الشاهقات في كونغ!”. هذه، بالمختصر، هي طريقة عمل التأثير البيوريتاني. أولا، جُرِّد عبد الرحمن من ديانته وتعريفه لنفسه. ثانيا، بدأت المؤسسات ذات النفوذ المتخصصة في الكتابة، وحفظ السجلات، والنشر والتعليم (وهي مهاراتٌ أساسيّة في تحويل التاريخ إلى ماض) بالتصرف لتشويهه بطريقتها الخاصّة.
قد تكون تفاصيل حكاية عبد الرحمن نادرةً. لكن تجربته كمسلم أميركي يواجه احتكارًا أنجلو بروتستانتي عازم على تصنيع بلد “مسيحي” ليست كذلك. لقد تطوّر الإسلام، جزئيا، بحيث عرَّش على الاختلافات اللغوية والثقافيّة الهائلة في أفريقيا وآسيا: عبد الرحمن كان يتكلّم ستَّ لغات. في حين أن البروتستانتية الإنجيلية للأنجلو أمريكيين، على العكس من ذلك، هي ديانة أحدث عُمرًا وأكثر ضيقًا. لقد اكتسبت قوامها في منطقة محدودة من شمال الأطلسي وبعلاقة ديناميكيّة مع كل من الرأسمالية والنزوع القومي. إنَّها تهدف لا إلى تجاوز الاختلاف ولكن إلى (كما كان كل من جالوديت وتابَّان يحاولان مع عبد الرَّحمن) فرض التجانس.
كم من الأشخاص شاركوا عبد الرحمن تجربته في مستوياتها الأساس؟ كم عدد المسلمين الذين كانوا هناك في أمريكا بين، إن قلنا، عاميّ 1500 و1900 للميلاد؟ كم منهم كانوا في شمال أمريكا؟ إن سيلفيان ضَّيّوف مؤرّخة بارعة في هذا الشأن. وفيما قد يُعتبر تقديرًا متحفظا، تكتب ضيّوف في “عباد الله” (Servants of Allah) الصًّادر عام 1998:
“كان هناك آلاف المسلمين في أمريكا ولعلَّ هذا ليسَ كل ما يسعنا قوله فيما يتعلق بالأعداد والتقديرات“
من الملايين العشرة أو أزيد الذين تم استعبادهُم من الأفارقة الذين أُرسلوا إلى العالم الجديد، ذهب أكثر من 80 بالمئة إلى الكاريبي أو البرازيل. برغم ذلك، كانت أعداد المسلمين الذين جاؤوا إلى أمريكا المبكّرة أكبر بكثير من أعداد البريتونيّين الذين جاؤوا في ذروة الاستعمار البيوريتاني. وقد شهدت نقطة الذروة من الاستيطان، بين عاميّ 1620 و 1640 للميلاد، قدوم 21.000 بريتوني إلى أمريكا الشمالية. وربّما جاء 25% من هؤلاء كخدم وكان من الصّعب، بالتبعية، افتراض وجود مشاعر وآراء بيوريتانيّة لديهم. وبحلول عام 1760 للميلاد، كانت نيوانجلند موطنًا، على أحسن تقدير، لـ 70.000 من أتباع الأبرشيّة (كنيسة البيوريتانيين في نيوانجلند).
برغم هذه الأعداد الضئيلة نسبيا، نجح البيوريتانيّون في التحوّل إلى جماعة من الأساتذة والمربيّين للأمة. لكن في بعض النواحي، كانت نيوانجلند أيضا خاسرةً في أثناء بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية. فقد وصلت إلى ذروة تأثيرها الاقتصادي والسياسي في القرن الثامن عشر. وبرغم دورها البارز في استقلال الولايات المتحدة، لم يحدث أبدًا أن كانت مركزًا للقوة الاقتصادية أو السياسية في المستعمرات البريطانية في شمال أمريكا، ولا في أمريكا العظمى أو حتى في الولايات المتحدّة كلها.
إن نظرنا إليها ببساطة كواحدةٍ من بين عديد مستعمرات العالم الجديد، ستكون نيوانجلند، بنواحٍ واضحة، حالة شاذّة. لقد كانت فريدة ديموغرافيا (بفضل استيطانها من قبل العائلات)، وطائفيّة دينيا، وشاذة سياسيا، وتابعةً اقتصاديا بالمنظور الأوروبي. وحتى جملة “نيوانجلند البيوريتانيّة” يُمكن أن تكون مضللة. فتجارة الأسماك والأخشاب والملاحة – لاسيّما، في تجارتهم مع المزارع الغرب هنديّة – وليس الديانة، هي التي جعلت الحياة في القرنين السابع عشر والثامن عشر في نيوانجلند ما كانت عليه. لم يكُن البيوريتانيّون بالضرورة محلَّ استحسان سكّان نيوإنجلند ولا كانوا ممثلين عنهم. وفي بداية القرن السابع عشر بمستعمرة خليج ماساشوستس، على سبيل المثال، قاطع أحد المستمعين في مرةٍ قسيسًا بيورتانيًّا قائلا:
“إنَّ الشؤون التجارية في نيوإنجلاند تختصّ بأسماك القدّ لا بالرب!”.
لكنَّ بعض المزايا ذاتها التي جعلت من البيوريتانيين غرباء إلى تلك الدَّرجة قد أتاحت لهم البراعة في كتابة التاريخ. لقد كانوا وبصورة استثنائيّة بارعين في الثقافة، والتعليم، وتأويل النصوص، وبناء المؤسسات. هذه المهارات مكّنتهم، على نحو يميّزهم عن بقية الأمريكيين، من التصدّي لتحديات التعامل مع ما أسماه عالم الاجتماع روجر فريدلاند “مشكلة التمثيل الجمعي” في العالم الحديث. فقبل بزوغ الأمم الحديثة، كان تاريخ الشعوب عبارة عن علم أنساب. حيث هناك جماعة تنحدر من سلف معيّن: إبراهيم أو أينياس، على سبيل المثال، وبالتالي فقد كانت الشعوب ترتبط ببعضها من ناحية طبيعية. لكنّ النموذج المثال في الأمة الحديثة قد مثَّل مشكلة جديدة. ذلك أنّه يفترض بالأمة أن تكون شعبًا واحدًا مُشتركا، يتشارك سمات جوهريّة بل موروثة، لا أن ينحدر من سلالة، أو ملكة أو ملك.
ومع نهاية القرن الثَّامن عشر، لم يكُن أي أحد تقريبًا يعرف كيف يمثّل هذه الجماعة المشتركة. لكن في أمريكا الشماليّة، كان النموذج البيوريتانيّ هو الأقرب. لقد ظنّوا بأنفسهم بل ودوَّنوا أنفسهم لا على أنهم جماعة مشتركة، ولكن على أنهم شعب مُختار، شعب لا يتقاسم النسب مع الرب لكنّه يتبع الرّب. وبُغية صهرِ تاريخ جماعة سكّانية متغايرة في بوتقة وحدة قومية، فلم يكُن ذلك مثاليا بأي حال من الأحوال. لكنه أمر كان يتعيّن عليهم القيام به.
لقد عمد التأثير البيوريتاني إلى استثناء كثير من الأشياء، بما فيها الحضور الطويل المديد للمسلمين والإسلام في أمريكا، وشيء من النزاهة والعاطفة في المعايير الخاصة للتجربة البيوريتانيّة، بعيدًا عن إسهاماتها في التَّاريخ القومي للولايات المتحّدة. لقد منحت هيمنة المؤسسات البيوريتانيّة نيوانجلند الاستعماريّة دورًا كبيرًا. وعلى مدار قرنين من الزّمن، كانت العادات والتقاليد قد تغيرت بدرجة كبيرة جدا، غير أن مؤرخّي القرن التاسع عشر العظماء من أمثال فرانسيس باركمان وهنري أدامز يتقاسمون مع أخلافهم من القرنين العشرين والحادي والعشرين بيري ميلر، وبرنارد بايلين وجيل ليبور التزامًا بإيجاد أمريكا، والأصول القومية للولايات المتحدة التي كتبتها نيوانجلند في القرن الثامن عشر.
إحدى أكثر السمات الضّالة في كتابة التاريخ البيوريتانية كانت زعمها بأنّ مشعل الحريات الدينية إنما هو ضرب من الالتزام الأنجلو بروتستانتي. وفي الحقيقة أنَّ البيوريتانيين والأنجلو بروتستانيين في أمريكا لطالما استعدَوْا بل واضطهّدوا المختلفين عنهم في الأديان: الأمريكيين الأصليين، الكاثوليك، اليهود، الشيوعيين، وجماعات المثليين، والمسلمين، وفي بعض الأحيان خصيصًّا، بروتستانيين آخرين. ولم يحدث أن عانى أي من جون وينثروب، أو كوتون ماثر أو أي جهة من طبقة ملاك الأراضي البيوريتانيّين اضطهادًا دينيًّا فعليًّا. إن امتلاك السلطة، على غرار الأنجلو بروتستانتيين في أمريكا، لا يتوافق كليًّا مع بعض الأسس التي تقوم عليها مزاعم السلطة الأخلاقية في المسيحية. ولا هو متناغم كليًّا مع فكرة أمريكا كأرضٍ للحريَّات الدينية، كما قال نصير المستضعفين، تون باين في عام 1776 للميلاد.
إن كان هناك أي مجموعة دينيّة يمكن لها أن تمثّل أفضل نسخة من الحريّة الدينيّة في أمريكا، فهي نسخة الزمّوري وعبد الرحمن. فقد جاءا إلى أمريكا في حالة من القمع الصّرف، وناضلا من أجل الاعتراف بدينهم وبحريّة ممارسته. وبعكس الأنجلو بروتستانتيّن، فقد اعترض المسلمون في أمريكا على الاستبداد بالآخرين، بمن فيهم الأمريكيين الأصليين.
لقد كانت النتيجة الأكثر ديمومة للتأثير البيوريتاني هي الالتزام المستمر بإنتاج ماضٍ يصب تركيزه على كيف أدت الإجراءات، التي عادةً ما تصوّر على أنها جريئة وذات مبادئ، للأنجلو بروتستانت (التي غالبا ما بدأت في نيوانجلند تشيسابيك) إلى [قيام] الولايات المتحدة الأمريكية، بحكومتها ومؤسساتها. والحقيقة أن تاريخ أمريكا ليس في الأساس حكايةً أنجلو بروتستانتيّة، بقدر ما أنه ليس تاريخًا للغرب بصورةٍ أوسع. وقد لا يكون من الواضح تماما ما الذي يقوم عليه، بالضبط، ذلك “الغرب”. لكن العصر الأكثر عالمية من التاريخ والذي بدأ بالاستعمار الأوروبي للشطر الغربي من الأرض قد يؤلّف جزءًا كبيرًا منه.
وإن كان الغرب، جزئيا، يعني غرب الأرض أو أمريكا الشمالية، فقد كان المسلمون جزءًا من مجتمعاته المبكّرة. ستظل الصراعات على ما يُمكن أن يكون أمة أمريكية ومن ينتمي إليها مستمرّة. غير أن الاحتمالات تظل مفتوحة على باقة من الإجابات المهمّة. تاريخيا، كان المسلمون [في أمريكا] أمريكيّين بقدر ما كان الأنجلو بروتستانتيين أميركيين بدورهم. وبالعديد من الطرق، فإنَّ المسلمين الأوائل في أمريكا نماذج يحتذى بها في الممارسة والمثل الدينية المشرِّفة في أمريكا. وأي تصريحٍ أو إشارة إلى النقيض، مهما كانت نواياها طيبة، ستكون مدفوعة إما بشوفينية متعمدة أو شوفينية كامنة.