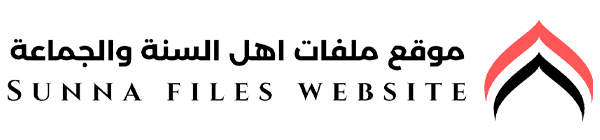منذ فاتحة العصر الإسلامي، جاءت آيات القرآن الكريم والسُّنة النبوية المشرفة بالحضّ –في مواضع كثيرة- على عدم الاغترار بالحياة الدنيا، فبينت أنها متاع زائل، وعرَض فارغ، ونعيم مؤقت، وأن الآخرة هي دار القرار، والحياة الحقيقية الخالدة، والنعيم السرمدي الدائم؛ ولقد آمن قطاع عريض من الناس بهذه المعاني، ورأوا أن الاستغراق في الدنيا خداع للنفس، وضياع للعُمر، وانهماك على ما لا يفيد ولا ينفع؛ ما دام الموت نهاية كل حي!
وقد بزغ من هؤلاء بعض من الصحابة ممن لُقّبوا بأهل الصُّفّة من الفقراء الذين لم يكن لهم مأوى إلا المسجد النبوي الشريف، فكانوا يعملون بأقل القليل، ويأكلون الكفاف الذي يسترهم ويبقيهم أحياء، ومنهم من اشتُهر بهذا الزهد مثل أبي ذر رضي الله عنه، الذي صار مضرب المثل، وصاحب السيرة الأشهر في ذلك المضمار.
وبالرغم من ذلك؛ ظل أغلب الصحابة آخذين بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي بيّنها في الحديث الصحيح لبعض ممن أراد التبتل من أصحابه؛ قائلاً لهم كما في صحيح البخاري: “أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي”.
لكن يبدو أن إقبال الناس على الدنيا، مع توسع رقعة الإسلام ودولته، ووفور الموارد، وكثرة الأموال، جعل نفراً من التابعين وتابعي التابعين من الجيل الثاني والثالث يرى أن الخوف من الدنيا وزينتها مبرر ومسوغ؛ فاشتهروا بالكفاف والزهد والورع، وعُرف رجاله بلبس الصوف أو الخشن من الثياب، وقلة الطعام، والقنوع بالقليل، والإيمان بصلاح النفوس وتهذيبها ومراقبة الله تعالى؛ حتى صار لهؤلاء وجهة ومدرسة كانت تتضح معالمها بمرور الأيام والسنين.
وقد بزغ من هؤلاء أعلام كبار أثّروا ولا يزالون في مسيرة التصوف الإسلامي؛ فمنهم من وضع قواعده الأولى، ومنهم من شرح أركانه ومعالمه، ومنهم شذّ عن الجادة وجاء بكل غريب مستغرب، ومن الصنف الأول وجدنا إبراهيم بن أدهم البلْخي، ذلك الرجل الذي كان من أوائل من وضعوا أسس التصوف وأركانه، وكان ذا سيرة وشخصية لافتة؛ ففي أي عصر عاش إبراهيم بن أدهم؟ وكيف انتقلت حياته من الغنى والدعة والثراء والإمارة إلى الزهد والترحال في أرض الله الواسعة؟ وكيف جمع مع الزهد والرحلة علماً عميقاً بالحديث والأخلاق والفقه وغيره؟ ذلك ما سنراه في سطورنا اللاحقة..
من التنعم إلى الترحال!
وُلد أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي التميمي العربي الأصل في مدينة بلخ في خراسان “شمال أفغانستان اليوم” في حدود عام 100 من الهجرة، لأسرة اختلف المؤرخون في شأنها، فمنهم من قال إن والده كان من أمراء بلخ في أواخر عصر الدولة الأموية، ومنهم من قال إن والده كان من علية القوم ثراء وغناء وحشماً وضياعاً وأولاداً وخيولاً ومواكب، فعاش إبراهيم ابنه مُنعّماً، يأكل أحسن الطعام، ويلبس أفخر الثياب، يروح ويغدو بنعيم كبير.
لقد تعلم إبراهيمُ الفروسيةَ ورمي القوس والتدرب على المبارزة والسباحة وعلوم الحرب في عصره؛ باعتباره سليلاً لأسرة أرستقراطية حكمت مدينة من كبريات مُدن خراسان آنذاك، أو ابناً من كبار أبناء التجار والأثرياء هنالك، كما حفظ القرآن الكريم وتعلم ما كان يتعلمه أبناء عصره، وقد أولع بالتنزه والصيد، على أنه في ذات يوم وهو في سن الشباب والفتوة قد واجه ما اعتُبر تغييراً جوهرياً في حياته كلها؛ إذ بينما كان منشغلاً في ملاحقة أرنب أو ثعلب في طريق صيده، إذا به يسمع هاتفاً من بعيد يقول: “ألهذا خُلقت، أم بهذا أُمرت” وتكرر على مسمعه هذا التساؤل، حتى جاءه الهاتف من جديد مجيباً: “والله ما لهذا خُلقت، ولا بهذا أُمرت”!
فنزل الشاب عن دابته، وأدرك مغزى الهاتف وقد نزل في قلبه منزلاً قوياً، وصادف راعياً لأبيه؛ أخذ منه جبّته من الصوف، ولبسها وأعطاه فرسه وما معه ثم ارتحل إلى الغرب صوب العراق، هكذا تخبرنا الرواية التاريخية عن سبب التحول في حياة إبراهيم بن أدهم.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
ساح إبراهيم بن أدهم في الأمصار الإسلامية، فجاب خراسان ثم العراق وأقام بعض الوقت في البصرة والكوفة فلم يصفُ له العيش فيها، فغادرها وقصد الحجاز فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرّج على مكة المكرمة، وصحب فيها سفيان الثوري والفُضيل بن عياض في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وانتقل إلى مصر والإسكندرية، لكنه على الدوام كان شغوفاً بالشام وثغوره الشمالية في المصيصة وطرسوس ومرعش التي تقع معظمها جنوب تركيا اليوم، والتي كانت حينذاك خط الدفاع والهجوم الأمامي لمواجهة الدولة البيزنطية في بلاد الروم “الأناضول”.
ويبدو أنه رأى بعضاً من تلك المدن في بعض مناماته قبل أن يأتي إلى بلاد الشام، فقد وله بها، وأحبّها: “قال سفيان بن عيينة: لقيتُ إبراهيم ابن أدهم رحمه الله في بلاد الشام فقلتُ له: يا إبراهيم تركت خراسان! فقال: ما تهنأتُ بالعيش إلا هاهنا، أفرّ بديني من شاهق إلى شاهق فمن يراني يقول موسوس أو حمال أو ملاح”!
مكث إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام شطر حياته الثاني كله، أي أكثر من خمسة وثلاثين عاماً قضاها متنقلاً بين مدنها وقراها وجبالها وثغورها، وقد زار بيت المقدس وقيسارية فلسطين وعسقلان وصور التي سكنها، وجبلة (في لبنان اليوم) التي تُوفي فيها، وكذا بيروت، ودمشق، وغزة والرملة وطبرية، وحمص، وحلب وغيرها، وهو في كل تلك السياحات والترحال، لم يكن مجرد زاهد أو درويش متواكل على غيره، بل كان يعمل من كد يديه وعرقه، يحصدُ البساتين في الصيف، ويحرسها في الشتاء، وينتقل إلى مدن الثغور مجاهداً في سبيل الله أمام العدو البيزنطي.
ويبدو أن والد إبراهيم وإخوته في بلخ قد وقفوا على مكانه، وعرفوا بعض أخباره، وتأثروا بما وصل به الحال من شظف العيش وضيقه، فأرسلوا إليه كسوة ومالاً مع عبدينِ مملوكين يكونان في خدمته، وهو في مدينة المصّيصة جنوب الأناضول، فأتاه العبدان وهو يحصد حقلاً، فلما لقيهما، قال لهما: “إن كنتما صادقينِ، فأنتما حُران، وما معكما لكما، لا تُشغلاني عن عملي”.
همُّ إبراهيم وفلسفته
وابن أدهم في كل تلك الأسفار كان يحمل همّاً عميقاً، وهو تحقيق الإيمان قولاً وعملاً في نفسه، وقد جاهد نفسه طوال حياته لإنفاذ هذه الغاية، حتى إن صاحبه سفيان الثوري الفقيه الكوفي والزاهد الشهير (ت 161هـ) حينما سُئل عن إبراهيم قال: “إن إبراهيم بن أدهم يُشبه إبراهيم خليل الرحمن، ولو كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان رجلاً فاضلاً له سرائر”.
وقد صدق سفيان الثوري في ذلك الوصف، فقد بدت علائم الإيمان والزهد على هذا الرجل الورع، فهو يحكي عن نفسه أنه عمل عند رجل ناظوراً “حارساً” على بستان من بساتين مدينة طرسوس الساحلية (في جنوب تركيا اليوم)، لأيام وأشهر، فإذا بصاحب البستان ذات يوم قد أقبل ومعه أصحابه، فقعد في مجلسه ثم صاح: يا ناظور. فقلتُ: هو ذا أنا. قال: اذهب فأتنا بأكبر رمّان تقدر عليه وأطيبه. فذهبتُ فأتيتُه بأكبر رمّان… فأخذ رمّانة فكسرها، فوجدها حامضة. فقال: يا ناظور: أنت في بستاننا منذ كذا وكذا، تأكل فاكهتنا، وتأكل رمّاننا، لا تعرف الحلو من الحامض؟ فقال إبراهيم: والله ما أكلتُ من فاكهتكم شيئاً، وما أعرف الحلو من الحامض. فأشار إلى أصحابه، فقال: أما تسمعون كلام هذا؟! ثم قال: أتراك لو أنك إبراهيم بن أدهم. ما زاد على هذا”!.
فلما عرف صاحب البستان أنه إبراهيم بن أدهم وتيقّن من ذلك، وكانت سيرته قد انتشرت بين الناس بالعلم والزهد والورع والتقوى والشفقة على الخلق، وتحري الحلال، اتخذ قراره بالهرب من طرسوس صوب الشام جنوباً؛ خوفاً من الشهرة وزينتها، فقد كان يقول دوماً: “ما صدق اللهَ عبدٌ أحبَّ الشهرة بعلم أو عمل أو كرم”.
سافر إبراهيم إلى مدينة صور جنوب لبنان التي مكث فيها وقتاً طويلاً، عمل فيها حارساً وحاصداً للثمار، ثم إلى عكا ومنها إلى قيسارية بفلسطين، وكانت مدينة من أمهات المدن آنذاك، حيث عمل فيها لحراسة بستان عنب، وبينما هو في إحدى الليالي؛ إذ سمع صريخ امرأة من داخل بيتها، فسأل عن حالها، فقيل له إنها على وشك الولادة، فسأل عن حاجتها، فقيل له إنهم يحتاجون سمناً وعسلاً وطحيناً ولحماً، وكانوا من أكثر الناس عوزاً وفقراً، فجاء بأجرته واشترى كل هذه الأشياء وحملها على كتفه في اليوم التالي وأعطاها لهم، فإذا أهل تلك الدار من أفقر الناس وأكثرهم بؤساً.
كان ابن أدهم على الدوام عابداً زاهداً ورعاً سخياً على الخلق وأصدقائه كما اشتُهر، مؤثراً لهم على نفسه، ينفق كل ما لديه على أصحابه ولو لم يبقِ معه شيئاً، وقد ذكر بعض هؤلاء كثيراً من الأخبار التي تدل على ذلك، حتى إن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وبيروت كان يؤثر ابن أدهم ويحب زهده وورعه مع سخائه الفذ وهو على تلك الحالة من الفاقة والفقر، يقول فيه: “ليس بين هؤلاء الفقراء أفضل من إبراهيم بن أدهم فإنه أسخى القوم”.
ولئن كان ابن أدهم فقيراً زاهداً ورِعاً جمع مع ذلك سخاء اليد والنفس، فقد كان عالماً محدّثاً ثقة، بلغ في علم الحديث منزلة رفيعة بين أصحابه، حتى إن سفيان الثوري على سعة علمه وغزارته كان يتحرز حديثه بحضرته، وقد وثّقه عدد من كبار علماء الجرح والتعديل مثل الدارقطني والنسائي، وخرّج له الإمام البخاري أحاديث في كتابه “الأدب المفرد”، وروى عن جماعة من التابعين وتابعي التابعين، مثل مالك بن دينار، وعمرو بن عبد الله السبيعي، ويزيد الرقاشي وغيرهم.
أحبّ العمل لله، وتمام الإخلاص له، كان يقول: “اطلبوا العلم للعمل، فإن أكثر الناس قد غلطوا حتى صارَ علمهم كالجبال، وعملهم كالذر”. وتجلى ذلك في رحمته بالناس، ومواساة أصحابه وفقراء الخلق كما مر في موقف المرأة التي جاءها المخاض فأمن لها حاجتها، و”كان إذا جلس على سُفرة بها طعام طيب تخلى عنه لأصحابه، وأكل الخبز والزيتون، وكان آخر من يرفع يديه عن الطعام تأدباً”.
متورعاً حتى الممات!
وهو مع فقره ذلك، وحرصه على الكسب من كدّ يديه وعرقه، وسخائه بكل ما لديه على الفقراء وأصحابه، كان يرفض أي عون أو مساعدة من كائن كان.
كما كان يتورّع عن قبول الهدية، ويأبى أن يأخذ سهماً أو نفلاً مما يُصيب المجاهدين في الغزو، وكان دؤوباً على العمل، شديد الصبر على مكارهه مخلصاً له، كان يحصد الزرع في النهار والليل أحياناً، فإن لم يجد حصاداً طاف بين الدور فنادى: مَن يريد يطحن؟ فكانت المرأة أو الشيخ يخرجان إليه بحبِّهما، فيُنصب الرحى بين رجليه فلا ينام حتى يطحنَ ما يُقدّم إليه منه، وإذا لم يجد طحناً أجّر نفسه في حفظ البساتين العنب، أو عمِلَ في كسر الحطب أو رعي الأنعام، وإذا ما ضاقت به سُبل الرزق الحلال طوى ثلاثاً وأكل في الرابع مجترئاً باليسير، حتى أصبح هزيلاً نحيلاً “كأنه ليس فيه روح، ولو نفخته الريح لوقع”، كما يقول بعض الدارسين لسيرته!
لقد كانت قضية الزهد والورع عنده تتركز على جماح النفس، والصبر عليها، وقهر شهوتها وأهوائها، والتوبة الدائمة وكان يقول في ذلك: “ما قاسيتُ في الدنيا شيئاً أشدّ عليّ من نفسي، مرّة عليّ، ومرّة لي. وأما أهوائي فقد استعنتُ بالله عليها، واستكفيته سوء مغالبتها فكفاني، والله ما آسى على ما أقبلَ من الدنيا ولا ما أدبر منها”. كما قال: “من أراد التوبة فليخرُج عن المظالم، وليدُع مخالطة من كان يُخالط، وإلا لم ينل ما يريد”، أي الإنصاف في معاملة الخلق، ولجام النفس، والابتعاد عن الظالمين.
وقد سُئل ابن أدهم عن الورع صراحة: “بم يتم الورع؟ فكان جوابه: بتسوية كل الخلق في قلبك، واشتغالك عن عيوبهم بذنبك”، فقلب المؤمن الورع عند إبراهيم بن أدهم هو القلب الخالي من الغل والضيق والحسد والشماتة؛ ذلك أن المؤمن الورع يُراقب نفسه، ويبقى حريصاً على تقويم مسلكه الشخصي، فلا يفرغ للسفاسف الصغيرة التي تجعل صلاته بالآخرين مشوبة بالجفاء والتوتر، كما يمتنع عن حضور مجالس الغيبة.
لقد اتخذ إبراهيم بن أدهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سراجاً له؛ إذ كان داعية بأخلاقه وأعماله أكثر من أقواله وشهرته، متخذاً في ذلك كله طريق الرفق والرقة، مع العلم التام، والجهاد بنفسه وبماله أمام العدو البيزنطي الرومي كلما سنحت له الفرصة، حتى وافته المنية مريضاً أثناء غزوه للروم في منطقة الجزيرة جنوب الأناضول في عام 162هـ. ثم نُقل جسده ودُفن في مدينة صور، وقيل مدينة جبلة (السورية)، بعد حياة تستحق أن تُدرس، كتب فيها الشيخ عبد الحليم محمود كتاباً مهماً بعنوان “إبراهيم بن أدهم شيخ الصوفية” كما تناولها غيره بالدراسة والتنقيب، ترك فيها ابن أدهم نعيم الدنيا وثراءها وزخرفها إلى حياة الزهد والترحال والجهاد والدعوة حتى مات على ما آمن به، فكان من أوائل الذين وضعوا الأسس الحقيقية لبناء التصوف الإسلامي الرشيد منذ عصره وحتى يومنا هذا!