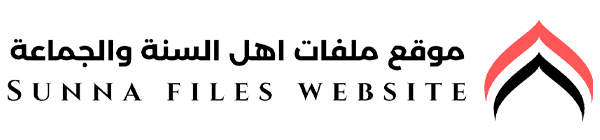حين كنتُ أدرس اللغة التركية، كانت زميلةُ الصف الآسيوية ترجو من الطلاب العرب التحدث أمامها، وهي تنصت دون أن تفهم كلمةً واحدة، وتقول إنَّ للغتِكم في أذني وقع الموسيقى، أستمتع بها وإن كنتُ لا أعرف ما تتحدثون عنه، حتى استطاعت مع الوقت أن تلتقط من أحاديثنا بعض الكلمات، فتقول “صباح الخير” مجتهدة أن تُخرج كل حرفٍ من مخرجه الصحيح.
في السكن الجامعي، كان زميل الغرفة يطاردني بكتابٍ به قواعد اللغة العربية، مشروحةً بالتركية، ولأنه يقرأ القرآن كثيراً، فإنه يريد أن يستلذ ولو بسورةٍ قصيرةٍ واحدةٍ، يفهم الآيات بينما يقرأها دون أن يُضطر إلى قطع التلاوة ليبحث عن التفسير بلغته.
في المسجد، حرص الإمام غير العربي أكثر من مرة على تقديمي لإمامة الصلاة، وعساه أحفظ منّي له، لكنه كان يأبى إلا أن أؤمهم، شاعراً بالعيبِ إن أمَّ الناس وفيهم عربيٌّ وراءه، كان يقول لي إنكم أهل القرآن، وأهل اللسان الذي نزل به، فمهما أتقنتْه ألسنتنا، يبقى الفضل لكم، وأنتم تفهمون ما تتلونه بحلاوته، لا بحلاوة التفسير، أي تفهمون كلام الله من الله مباشرةً بكل معانيه، لا تسمعونه ثم تنتظرون الترجمة.
في أي جلسةٍ معرفية، كان يُنظَر إلى الطالب العربي أنه أخيَر الموجودين، ليس من اجتهاده ولا من علمه، وإنما لأن لسانه جمع المحاسن كلها، فأجاد البلاغة في كل لسانٍ آخر، ولأنه يُخرج الحروف من مخارج ما زالت مغلقةً عندهم، فكذا اتسعت مداركه بقدر اتساع مخارج حروفه، ويا حبذا لو قال العربي شعراً أمامهم، لذابوا مما يسمعونه بغض النظر عن المعنى، حتى يُخيّل إليَّ أنك لو قلت بيت هجاءٍ أمامهم لظنوه من حلاوة سماعه مدحاً.
في جامعتي الأولى، ببلدي العربي، وبينما كنتُ في قسمٍ يدرس بالإنجليزية، لإتاحة تلك الميزة عملاً بظروفٍ أفضل خارج البلاد، كانت الدراسة تشمل مناهج أمريكية، وكان الحديث في أثناء المحاضرات بالإنجليزية فقط، وكان ذلك جيداً لأن الأصل في ذلك المقام الدراسة، وعلينا أن نخضع لما قررناه،
لكن، لم تكن الأمور تتوقف عند هذا الحد، وإنما كانت الإنجليزية هي الطابع الرسمي في كل شيء، من يريد أن يقول شيئاً لصديقه يقوله بالإنجليزية، ومن يريد أن يمزح فإنه يفعلها بالإنجليزية، ومن يتندر على شيء أو يتحدث جدياً في شيء، ومن يقول هيّا لنأكل، أو فلنذهب إلى مكانٍ ما، الكل يتحدث الإنجليزية بلا سبب، بل إنهم “يتلككون” ليتحدثوها، حتى إذا ذهبنا إلى أيٍّ من مطاعم الحرم الجامعي، يكاد الطالب يطلب من البائع ما يريد بعربيةٍ مكسّرة.
وكنتُ أنظر إلى ذلك في ذهول، تارةً بعينِ العربيّ الناقم على المنسلخين عن أصولهم، وتارةً بعين القرويّ المبهور بأضواء المدينة، الذي أتى فجأة إلى مجتمع لا يرى في العربية إلا خطبة الجمعة التي يحضرها كل شهرٍ مرة، والخطيب الذي يتخيله قادماً كل جمعةٍ من الحجاز، وهؤلاء الناس ذوي الذقون المهملة، الذين لا يتسامرون عِشاءً على مقهى شعبي، وإنما تجمعهم خيمةٌ في سوق عكاظ.
وكنتُ أحسبهم جميعاً منسلخين عن هويتهم، لكنني تفاجأت أنهم لا يعرفون ذلك، هم كبروا بين أبٍ وأمٍّ حرصا من الدقيقة الأولى على أن يُلحقوهم بمدارس لا تُعلِّم الإنجليزية وحسب، وإنما تحتقر العربية، فلا ينظرون إلى متحدثي العربية -في بلدهم العربي- إلا أنهم أسافل القوم الذين يستحقون شفقتهم وعطاياهم، ورغم محاولاتهم لارتداء ثوب التواضع، فإنه يكون مفضوحاً جداً مشاهدتهم للعامة من نافذةٍ بالأعلى.
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website
وكبر هؤلاء، وأصبحوا رجالاً بشوارب، وأصبحت الفتيات سيدات، وعيونهم لا تزال ضيقةً كما هي منذ نشأتهم، لا يجيدون التعبير عن أنفسهم أو حاجاتهم إلا بلغتهم الإنجليزية التي أصبحوا يتحدثونها أفضل من متحدثيها الأصليين، ويتبادلون النُّكات على كل من ينطق حرفاً من غير مخرجه، أو يتحدث اللغة الأجنبية بلهجةٍ متكسرة، بينما هم يتفاخرون بدرجاتهم الوضيعة في امتحان اللغة العربي لثانويتهم، والذي لم يكن مضافاً إل المجموع، وإنما كانت اللغة العربية حالها حال الدين، تجمعهما خانتان متجاورتان، بعد خانة المجموع، لا قبله.
ونشأ مجتمع “الماميز” -جمع ماما أو مامي، لا جمع أم- يقولن لأبنائهن “ياس أو يب” في حالات الموافقة، و”نو” في حالات الرفض، يخطئون فيضعنهم في الـ”نوتي كورنر”، ويُحسنون فيحضّرن لهم “سربرايز”، وقد يأتيها ابنها وقد فعل ما فعل، وقد أجرم ما أجرم، لكن أي شيء عندها أهون من أن يتحدث طفلها بكلمة عربية، من علمك هذا؟! من قال لك تلك اليوم في المدرسة؟ ويشتعل الحوار الساخن على المجموعة الإلكترونية التي تجمع الـ”ماميز”، وتقوم الدنيا ولا تقعد، لأن مازن ابن مسِز عُلا حدّث اليوم آدم ابن مسز نورهان بكلمةٍ عربية، وجاء الولَد يقولها لمامي بمنتهى الوقاحة اليوم.
وأتخيل آدمَ ابن مامي نورهان تائهاً في إحدى المناطق الشعبية، يكاد يتحدث العربية في أضيق الحدود، وهو لا يستطيع أن ينقذ نفسه من ورطته، لأنه تاهَ في مجتمع سفلي، في طبقة سحيقة لا تعرف الـ”يس” والـ”نو” إلا في سياق فكاهي وكراسات أبنائهم القادمين من حصة الإنجليزي، فلم يلتقوا من قبل إلا بخواجات خواجات، قادمين من بلاد برة، لكنهم لأول مرة يلتقون بخواجات يحملون بطاقات هُوية بلادهم، لهم الجنسية ذاتها، كأن “الخوجَنة” لا ترتبط بهوية معينة.
لكن اللغة -حضرات الماميز- ترتبط بهوية معينة، لا بد أن تدل اللغة على الهُوية، ولا بد أن اللغة أصل من أصول الهوية، ولعل صاحب الحكمة “حدثني لأعرف مَن أنت”، كان يقصد بها شيئاً آخر، وهو أسمعني قولَك أعرف لغتك فأدرك هُويتك.
وفي بيئة الماميز، مع اللغة تأتي بهارات أخرى فوقها، فتصبح القُبلة مجرد “كِيس” بسيطة، خطفها مازن من خد صديقته جمانة، ويصبح الأمر مجرد فكاهةٍ على الغداء الذي ربما يجمع العائلتين، لكن ذلك في مجتمعٍ موازٍ بعيد عنهم، ستحذر “الأمهات” أطفالهن من أن يكرروا ذلك، لأن “البوسة” عيب، لكن المجتمع المرتفع يرى تلك الأم رجعية، ويكفي أنها “أم” لا “مامي”.
ويكبر الأولاد، ويعبُرون ببطاقة اللغة حواجز كثيرة عبرها متحدثو اللغة الأصليين، فتتجاوز اللغة مجرد اللسان إلى الجوارح والجوانح، فلا يعبّرون عن دواخلهم إلا بلغة غير التي وُلدوا بها، حتى يكاد الشاب منهم في أسعد لحظات حياته، لن يقول “بحبك” أو “أحبك”، وإنما سيقول “آي لاف يو”، ليشعر بحلاوة الكلمة.
وتمر اللغة عبر الأضلع والأعضاء، ويصير الولد أجنبياً من ساسه لراسه، ويخرج إلى المجتمع مشوَّهاً لا يقدر على تحديد أصله، وسرعان ما يجد النجاة في أن يتبرأ منه، ويزدري المتمسكين بأصلهم، “لماذا يتمسكون به أصلاً؟”، وربما يفتح مازن شركةً باسمٍ إنجليزي، وعلى طرازٍ أجنبي، يتراسل فيها جميع الموظفين العرب بلغة إنجليزية، رغم أن طاقم الشركة ليس به أجنبي واحد، لكن الإنجليزية شرط من شروط العمل الناجح، لأن الرزق عندهم لا يأتي إلا بلغة إنجليزية.
ويعيشون في دوائرهم الواهمة المغلقة عليهم، بعيداً عن الواقع الحقيقي، لا يرون اللغة العربية إلا متمثلة في عم أحمد الذي يصنع لهم الشاي والقهوة في المكتب، ويمنحون عم أحمد اسمه الوظيفي “أوفيس بوي”، وهكذا، كلما سمعوا حولهم من يتحدثون العربية، يُخيَّل إليهم أقوام في ثياب مهلهلة، يسيرون في الرمال لا على الأسفلت، يركبون الناقة لا السيارات، ويعيشون في خيامٍ على طريق الحجاز.
واأسفي عليهم، أو سخطي عليهم، أو شفقتي عليهم، أن الواحد منهم لا يستطيع التعبير ولو بجملة عربية كاملة واحدة، دون أن يضطروا للاستعانة بالأجنبية، وقد حُرموا من لغة واسعة المعاني رقيقة المباني، لا يتحير أهلها في اختيار أي ألفاظها، فلكل موقف كلمة، ولكل كلمة معنى، ولكل معنى مستوى، ولكل مستوى حديثه الذي يليق به، وأتخيل لو أن إنساناً أفنى عمره يتحدث بالعربية دون أن يكرر أي كلمةٍ قالها مرتين، لقضى أجله قبل أن تفنى تعابير اللغة.
ولا نحتاج إلى التأكيد على أن تعلم اللغات أمر محمود، لكن النقص مذموم، وأن يتملص الرجل من لغته الأصلية، فإنه انسلاخ له عن أصله، ومن ينكر لغته الأم كمن ينكر أمه، ولعل لو أن أحداً من ذوي اللغة الأجنبية قدم إلى بلادنا فوجد عرباً يتحدثون لغته فيما بينهم، لشعر بغرابة واشمئزاز، فهو لا يتحدث لغته إلا لأنها لغته، لا دليل تميز ولا يحزنون، لكنهم يتحدثونها كدليل على طبقتهم الاجتماعية. سيبصق عليهم الأجنبي ثم يولّي منصرفاً، وسيكونون هم الوحيدون الذين اجتمعت فوق رؤوسهم البصقتان، هذه من ابن البلد، وتلك من الخواجة.
يا صديقي العزيز.. الزم لغتَك تُكرم، وتحدث بها في كل موضعٍ عدا استثناءات تستلزم لغةً أخرى، ولا تترك أحداً يحتقرك لأنك أصيل تعتز بلسانك، واحرص على تقويمه بها أكثر فأكثر، واشرح لكل خواجة عربي، أن هجر العربية نقصان، فإن التحدث بغيرها لن يزيدك، وإنما تركك لها سينقص منك كثيراً، ويكفيك خسارتك لهُويتك الكريمة، ولهثك خلف رجل بصق عليك في الفقرة السابقة.
المصدر: عربي بوست- بتصرف