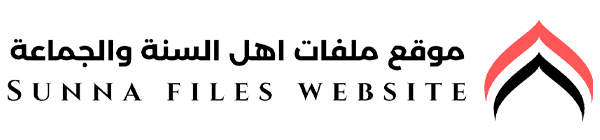أقيم في مدينة ليست ككل المدن، وإني لا أرى سواها، ولا أتنفس إلا عشقها، وكيف لا وهي مدينة حبيبي خير خلق الله، ولست أنا من أقيم فيها بل هي فىّ مقيمة، وقد قالوا عن الغربة الكثير ولكن كيف لها بغربة وأنت في كنف الحبيب مدام؟ كيف بأنس يؤنس وحشتك وفي الطرقات عبق المسك كأنه رائحة الجنة؟ كنت أظن أن ينتج العشق بين الأشخاص، ولم أظن يوما أن تذوب الأماكن في قلوب عاشقيها، وأن يبقى أثر المحبوب باقيا إلى اليوم يزين طرقاتها وينير شوارعها، ويأثر قلوب ساكنيها، فيأخذ المكان وجوده على أرض الواقع وينعكس وجدانيا في القلوب.
يحدث بين الأشخاص العاديين أن من يتوق لحبيبه يرق قلبه عند مدخل شارعه، أو قرب منزله، ولم يحدث أن يرق القلب عند مدخل مدينة بأكملها، من المدينة الأخرى التي ابتعد عنها، وحتى تحليقه بالطائرة ليتسع شوقه ملء السماء. يلفح وجهك هوائها العليل فتشرق الشمس من جديد لتضيء القبة الخضراء فيخضر كل ما حولها، وتنبثق معه سكينة تُشعِر الناس بالجنان الخلد، يسرى في دمك سكونها وروعتها، يغلق عقلك عن كل ملاذ الدنيا، عن كل شذرات يومك، وحتى عن خططك المستقبلية، يبتهج وجهك عند لمح اللوحة المكتوب عليها “إلى المسجد النبوي” كأنه يعرف حق اليقين مصدر الابتهاج دونا عنك، يعي وجهته الذي فطرها الله، ويرسم ابتسامة لم تكن في الحسبان. ففي المدينة يتسق كل شيء مع ذاته ومع ما حوله، فيعانق أُحُدا السماء، ويحتضن طيبة حضن المحبين، ويرفرف النخيل معلنا بدء عهدا جديدا، عهد أحباء الحبيب الذي كان يشتاق اليهم، ويتسق حمام المدينة – الذي أخذ شهرة عالمية – مع قبب المساجد الذي اتخذ منها بيوتا له، فيزيد الألفة ألفة ويزيد معها الاطمئنان.
حتى أنى رأيت شخصا يتسق مع تاريخ المكان، كنّا نزور شهداء أُحُدا يوما ورأيت عجوزا بثياب رثة، بالية، تبدوا عليه الكهولة من التجاعيد التي ملئت وجهه ويديه، يدعوا ويبكى بحرقة كأن لم يبكى من قبل، أخذت أراقبه، تلك المشاعر التي انفجرت فجأة وهزت كيانه لم تكن وليدة اللحظة، بل تعمقت في جذور قلبه عبر السنوات، وخرجت كالسيل المفاجئ، كدت أبكى أنا الأخرى، وشعرت بغبطة مما هو فيه، لم يفارقني مشهد الرجل من وقتها، هو وغيره من الأشخاص يتسقون مع المدينة، ويتسقون مع تاريخها.
يشع النور بها ومنها وفيها، يمتزج مع ما حوله، فيرسم لوحة نادرة الوجود، فتبقى “منورة” كاسمها، ومعرفة بالألف والياء “المدينة”، محبوبة الجميع، وكيف لا يحبها من سمع عنها أو رآها؟ فما بالكم بمن سكن فيها، وداب سكنه في سكينتها؟ أليفة الجميع، يألفها من زارها ساعة، ومن سكنها عدى حدود الألفة. أدخل ساحات المسجد النبوي، وكأنها ساحات من الطيبة والإجلال التي تثقل القلب، أخوض في الزمان فأنتمى للمكان، فهنا الصدّيق، وهنا سيد الشهداء -الذي سميت ابنى على اسمه- وهناك عليّا يضحك مازحا مع الحبيب لأنه أكل كبشة كبيرة من التمر، تعود للنوى الذي أمامه، فيرد الحبيب بدعابة وحنكة، ويسأله (وهل أكلت أنت التمر بالنوى؟)، رضى الله عنهم أجمعين.
في المدينة عرفت الإسلام من جديد، كأن لم أعرفه من قبل، وعرفت نفسى معه، وقد علمنا الإسلام حب المدينة، وحب ساكنيها، عرفت ذاتي التي انغمست في حب المكان وحب النبي وصحابته، حب أُحُدا وقباءا ووداي العقيق، والمسجد النبوي، حب الشوارع والنخيل، حب السكينة والدفء، حب الرفقة والأنس، وحب من يحبهم. تأتي الناس إلى المدينة حبا وشوقا ورغبة في وصال الحبيب، يرق قلبهم من غير إذن فيصير كقشة طليقة يأخذها الهواء يمينا وشمالا، ويغادرون إلى بلادهم موقنين أن ثمة مكانا أخر أجمل من بلادهم، مكانا يشبههم، ويشبه أرواحهم، قد يفضّلون إقامته عن الإقامة في بلادهم، لأن روحهم اشتاقت سريعا لذاك المكان وعادت تحثهم على الرجوع. كل المدن سواء إلا طيبة فإنها سيدة كل المدن، فيها وفينا تقيم، مهما تجملت الأوطان وبقى ذكرها خالدا في القلب، تبقى طيبة منبعها، ومنبع كل جمال يكمن في الكون، يدّعون بأن لهم أوطانا ويا ليت طيبة كل الأوطان.
بقلم الزميلة آيات تليمة
Sunna Files Free Newsletter - اشترك في جريدتنا المجانية
Stay updated with our latest reports, news, designs, and more by subscribing to our newsletter! Delivered straight to your inbox twice a month, our newsletter keeps you in the loop with the most important updates from our website